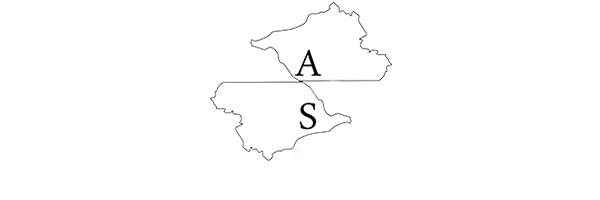هرمجدون في نسخها الحديثة
بول بيرمان
في فترة الخمسينات تقريباً، شرع كتابٌ في أنحاء مختلفة من العالم في إنتاج أدبيات تحليل سياسي جديدة تختلف عن جميع أدبيات الماضي السياسية. وهدفهم وصف وتحليل الأهواء السياسية الشمولية في القرن العشرين الذي كان موضوع الساعة آنذاك. وثمة كثيرٌ من هؤلاء الكتاب، نذكر منهم حنة آرندت، وجورج أورويل، وألبير كامو، وسيندي هوك، وسي إل آر جيمس، وأليجو كاربتنييه، وسيزلاو ميلوش، وديفد روست، وآرثر كوستلر، وآرثر إم شليزنغر الأصغر، وريتشارد رايت، وغيرهم من المساهمين في كتاب ريتشارد كروسمان "الإله الذي أخفق"، وغيرهم كثر. وجاءت هذه الأدبيات الجديدة ضمن كل ما يخطر بالبال من أشكال: البحث الفلسفي، والخيال العلمي، والقصة التاريخية، والنقد الأدبي، والصحافة، والبحث التاريخي، وكذلك الاعترافات التي تحملها السير الذاتية. وهؤلاء الكتّاب مختلفون فيما بينهم. فهم ليسو عصبةً واحدة. على أن كتبهم ومقالاتهم وقصصهم تشترك في صفةٍ واضحةٍ جداً. إنها نبرتها الموحدة التي تعبر عن شعور مشترك: الدهشة.
بدأ كلٌّ من هؤلاء الكتّاب حياته عدواً للفاشية ولليمين المتطرف في الثلاثينات والأربعينات. ثم بدأ كلٌّ منهم بعد فترةٍ، يلاحظ أن الشيوعية في عهد ستالين كانت مرعبةً جداً بدورها. وخرج كلٌّ منهم بملاحظةٍ إضافية كانت منذرةً بالخطر حقاً. ثمة عداءٌ عنيف بين الفاشية والشيوعية، وهما ضدان لا يلتقيان. لكن هذان الضدان يبدوان متشابهان على نحوٍ غريب إن جرى النظر إليهما من زاويةٍ معينة. وقاد هذا الشبه الواضح إلى قلقٍ لا يعرف الاستقرار. فهل ثمة احتمالٌ في أن تكون الفاشية والشيوعية مترابطتان على نحوٍ ما؟ أو لا يمكن أن تكون الحركتان ناشئتان عن مصدرٍ أوليٍّ أكثر عمقاً؟ أولا يمكن أن تكون الفاشية والشيوعية مخلبان من مخالب وحشٍ واحدٍ أكثر ضخامةً آتٍ من الأعماق؛ مخلوقٌ مرعبٌ جديد من نتاج الحضارة الحديثة لم يره أحد ولم يُعْطَ اسماً، لكنه قادرٌ رغم ذلك على إرسال مخالب شنيعة أخرى من تلك الأعماق المرعبة؟
في أوروبا، وليس في أوروبا فقط، بدا أن ثمة حراكاً لنوعٍ جديدٍ من السياسة راح يدعو نفسه باسم اليسار أحياناً وباسم اليمين في أحيانٍ أخرى: سياسةٌ ديماغوجية لا عقلانية سلطوية، ووحشيةٌ إلى حدِّ الجنون. إنها سياسة التعبئة الجماهيرية من أجل غاياتٍ لا يمكن تحقيقها.
اعتمد موسوليني كلمة "شمولية" لوصف حركته؛ وبدت نغمة تلك الكلمة مناسبةً تماماً لذلك النوع الجديد من السياسة في كل نسخةٍ من نسخها الكثيرة، يساريةً أو يمينيةً على حدٍّ سواء. وبدت آثار ذلك واضحةً كل الوضوح. فخلال القرن التاسع عشر كله، وفي السنوات الأولى من القرن العشرين، رأى كثيرٌ من المفكرين المتنورين والتقدميين أن خطراً رئيسياً (ولعله الخطر الرئيسي) يتهدد الحضارة الحديثة يأتي من اتجاهٍ سياسيٍّ بعينه هو اليمين المتطرف؛ والأرجح أن مصدره بلدٌ واحدٌ هو ألمانيا، فهي العدو المبين للثورة الفرنسية. لكن تلك النظرة راحت تبدو باليةً إلى حدٍّ كبير في الخمسينات. ففي تلك الحقبة الجديدة، لم يكن أحدٌ يشك في أن بوسع حركات اليمين المتطرف السياسية أن تظل مثار قلقٍ. ولم يشعر أحدٌ بكبير ثقة في ألمانيا وفي تقاليدها السياسية.
لكن كتاب أواسط القرن العشرين رؤوا بوضوح أن الخطر على الحضارة تجمع في روسيا وبين الستالينيين المتشددين، وغيرهم أيضاً. وأبدى الكتّاب قلقهم أيضاً من الليبراليين المائعين ومن يسير بركابهم في مختلف أنحاء العالم ممن توصلوا إلى الإعجاب بالمشروع الستاليني رغم أنهم ليسو من الستالينيين. وخشي الكتّاب من المد الشمولي حتى في مناطق يستبعد أن يرسل الجيش الأحمر دباباته إليها. وخشوا أيضاً وجود مواطن ضعفٍ خفية تفتح شقوقاً في الحضارة كلها. وكان هذا الخطر عالمياً.
كانت اللينينية أول تلك الحركات المعادية لليبرالية. وقد أقامها لينين عبر الجمع بين اثنين من تيارات الماضي: الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا، والإرهاب المسلح الذي مارسه الاشتراكيون الثوريون الروس منذ 1905 تقريباً. ومنح هذا الجمع حركته التي أقامها، وهي البلشفية، برنامجاً نبيلاً (برنامج الاشتراكية الديمقراطية)، وكذلك حدةً أخلاقيةً يصعب إرضاؤها (استمدها من الاشتراكيين الثوريين). لكن تلك الحدة الأخلاقية في الحركة اللينينية تنحت جانباً من فورها مفسحةً الطريق أمام عقيدة العشوائية. وسرعان ما جرى التخلص من العادات العقلية للعالم المحيط بكالياييف "الشاعر" بوصفها الإرث العاطفي المنحدر من الماضي المشبع بالنفاق؛ إنها الإلحاح القديم على التمييز بين المذنب والبريء، ومن الإدراك المخلص بأن الأفعال العنيفة يمكن أن تكون مدانةً أخلاقياً مهما تكن مبرراتها، ومن التقليد المتشدد القاضي بأن يتبصر المرء في دوافعه. كان الإنسان خاطئاً في نظر لينين؛ لكن التاريخ كان بريئاً. لقد أمر بتنفيذ إعداماتٍ جماعية، وكان كل ما فعله بريئاً كل البراءة تعريفاً.
كان أحد أوامر لينين السرية يقول: "اقتلوا جميع البروفيسورات". لم يقدم سانت جوست نفسه على إعطاء من هذا النوع. وعلى نحوٍ سريعٍ جداً، انتشرت حركة لينين في أوروبا والعالم كله بعد إمساكها بالسلطة في سانت بترسبورغ عام 1917. وفي كل مكان، أبدت تلك الحركة الجديدة حيويةً مسعورةً غريبةً تجاوزت كل ما عرفه القرن التاسع عشر. وكانت تلك قوةً عاطفية مستمدة في نهاية الأمر من استعداد تلك الحركة لقتل جميع أعداء البلشفية، وكذلك استعدادها المماثل لقتل أية حشودٍ لم يكن رأيها بالبلشفية معروفاً أبداً، إضافةً إلى استعدادها لقتل البلاشفة أنفسهم (لم يقتل أحدٌ عدداً من الشيوعيين يفوق ما قتله الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي)، بل وأيضاً استعداد المرء لتقبل قتله، وكل ذلك من أجل الغايات النبيلة. وكانت الفكرة، كما يقول بودلير، جلد الناس وقتلهم لمصلحتهم. وراح الجلد والقتل يسيران ويسيران.
لكن تلك لم تكن إلا بدايةً كما أرى. ففي عام 1922، زحف فاشيو موسوليني إلى روما. هل كان ثمة شبهٌ بين فاشيي إيطاليا وبلاشفة روسيا؟ كان الظاهر أنهم مختلفون من جميع النواحي. كانت البلشفية تحلم بتحرير البشرية كلها؛ أما الفاشية فحلمت بتحرير جزءٍ منها فقط على حساب كل ما عداه. زعم البلاشفة أنهم أبطال العقلانية والعلم (رغم أن علمهم وعقلانيتهم كانا عقيدةً صوفيةً جامدة بكل المقاييس)، وزعم الفاشيون أنهم أبطال اللاعقلانية (وهم صادقون في زعمهم هذا). كان البلاشفة أمميين، وأقاموا فروعاً لحزبهم في جميع البلدان بصفتها فروعاً لحزبٍ مركزيٍّ موحدٍ يتبنى خطاباً واحداً ويقرأ النصوص ذاتها ويردد نفس الشعارات في كل مكان. (الأممية الشيوعية: إنها الأقواس الذهبية الأصلية). أما فاشيو موسوليني فكانوا قوميين بخلاف الشيوعيين، وكانوا فخورين بأمجاد تراثهم القومي، كما يعرفونه بأنفسهم.
وعلى الرغم من هذه الفوارق كلها، بعث فاشيو موسوليني رعشة إثارةٍ وحسد في أرجاء العالم لم تكن بعيدةً عن الرعشة البلشفية التي أثارها كلٌّ من لينين وثورة أكتوبر. كان موسوليني عملاقاً كما كان لينين (رجلٌ ذو إرادةٍ لا تلين يملك من القوة ما يكفي لتحويل الفوضى إلى نظام، وقادرٌ على إمساك السكة الحديدية التي يسير عليها قطار التاريخ وليّها كما يريد). أما التمييز بين اليسار واليمين فهو تمييزٌ يدعو للرثاء إذا نظرنا إليه من زاويةٍ معينة. لقد بدأ موسوليني نفسه في اليسار المتطرف (ضمن القطاع الفوضوي في اليسار الإيطالي الذي أنتج لويجي غالياني)، ثم لم يشعر بأي حرجٍ عند انتقاله إلى أقصى اليمين. وكما انداحت البلشفية في أرجاء العالم سريعاً، بدأت الفاشية (بصفتها حركة يمينٍ متطرف تخالطها بقايا بسيطة من اليسار المتطرف) تنتشر بسرعةٍ عجيبة. لكن من الطبيعي أن انتشار الفاشية جرى وفق نموذجٍ مختلف عن انتشار البلشفية: نموذج الفوارق القومية بدلاً من الوحدة الأممية.
كانت حركة موسوليني إيطاليةً على نحوٍ صاخب، أما كتائب فرانكو في إسبانيا فكانت إسبانيةً على نحوٍ صاخب (كانت يمينيةً وكاثوليكيةً متشددة ممتلئةً بالكره إزاء الثورة الفرنسية). ثم ما لبث اليمين المتطرف الفرنسي أن أثبت أنه فرنسيٌّ على نحوٍ صاخبٍ أيضاً، وأنه يحن إلى أيام الملكية الفرنسية، وأنه يحمل قدراً أكبر من الكره للثورة الفرنسية. وهكذا، شهد كل بلدٍ في أوروبا، وفي كل مكان، حركةً جديدةً متوقدة للمتشددين القوميين. وهي حركاتٌ راحت تدّعي في كل مكان أنها تجسد حقيقةً عميقة، وأنها تحمل التراث المحلي الأصلي المغروس في دم الشعب وتراب الوطن، كما أكدت كلٌّ منها على خصائص فردية لا شبيهة لها.
ثم تبين أن كلاً من هذه التنويعات الفاشية العميقة والحقيقية والأصيلة شبيهةٌ ببعضها بعضاً. كانت اشتراكية هتلر القومية أكثرها تطرفاً؛ وهي الحركة اليمينية الأوروبية الوحيدة التي (في حبها الشديد لنيشة) حاربت المسيحية فعلاً بدلاً من ادعاء حمل لوائها. كان النازيون متوحشين إلى حدٍّ جعل غيرهم من الفاشيين في أنحاء العالم من أصحاب التقى المسيحي يعجبون لهؤلاء الآلهة الشماليين ولعودة الوثنية فيهم. لكن أعين هؤلاء الفاشيين الآخرين رنت إلى هتلر فرأت فيه صديقاً ورفيقاً وزعيماً؛ رأت فيه شخصاً يمكن الهتاف له والاتفاق معه، فهو أعظم أبطال الفكرة القومية على وجه البسيطة: إنه أقوى أقوياء الإرادة إرادةً. ولم يكونوا مخطئين في هذا. ففي موضوع الموت، كان النازيون أنقى الأنقياء. وكانوا أبعد الناس عن الأخلاق، وأكثرهم جرأةً؛ وكانوا أكبر القتلة. لكنهم كانوا أعظم ضحايا الموت وأسماهم أيضاً: كانوا أناساً يعرفون كيف يحسون الثورة بالاتجاهين كما عبر بودلير. فقد كان الانتحار حركة الختام بالنسبة لنخبة النازيين في برلين. فالموت في نظرهم لم يكن للآخرين فقط، إذ حوّلوا منازلهم الآمنة عند هزيمتهم النهائية عام 1945 إلى معسكرات موتٍ مصغرةٍ لهم.
وفي أمريكا اللاتينية، تكفّل الحقد المتبادل بين البلاشفة (الذين اتخذوا أسماء مختلفة بعد حينٍ من الزمن) والفاشيين (الذين اتخذوا أسماء جديدة أيضاً) بوقوع حروبٍ في الثمانينات وما تلاها، وحروبٌ جرت في عددٍ من مناطق الأدغال النائية، والأرجح أنها ستظل متقدةً بعد خمسين عاماً من الآن. لكن، ورغم الحقد المتبادل والسعي المستمر لقتل بعضهم بعضاً، فقد صار من الواضح تماماً (وهو ما كان واضحاً للكتّاب المعادين للشمولية منذ أواسط القرن) أن لينين وورثته الكثر، وكذلك موسوليني وورثته، ليسو إلا تنويعاتٍ لدافعٍ وحيد سواءٌ كانوا يميناً أو يساراً. لقد كان ما لاحظه ألبير كامو حقيقةً.
لقد لاحظ كامو دافعاً حديثاً لدى الثوار، وهو ناجمٌ عن الثورة الفرنسية وعن القرن التاسع عشر، وقد تحول (باسم المثل) إلى عبادةٍ للموت. كان ذلك نوعاً من الخضوع لنوعٍ من السلطة التي قوضتها الحضارة الليبرالية ببطء، والتي أرادت الحركات الجديدة إقامتها من جديد على أسسٍ مستحدثة. لقد كان ذلك مثل الفرد بدلاً من مثل الجماعة. إنه مثلٌ لشيءٍ أشبه بالإله: الدولة الكلية، والعقيدة الكاملة، والحركة الكاملة. صحيحٌ أن تعبير "الشمولية" يخص موسوليني؛ لكن الرجل كان ينطق بلسان الجميع.
تبنت كلٌّ من هذه الحركات عين المجموعة من الطقوس والرموز من أجل التعبير عن مثلها: الجماهير التي تنشد جماعياً، والصروح المعمارية، والإيمان بالزهد على مستوى الفرد، والإصرار على عدم إعمال العقل في العقائد المقررة قبلاً. واختارت كلٌّ من هذه الحركات لوناً يرمز لها ويمثل وحدانية السلطة: الأحمر، والبني، والأسود. واتخذت كل الحركات القميص لباساً موحداً لها: الأحمر أو البني أو الأسود. وروت كلٌّ منها نظريةً عن التاريخ والبشر تكفلت بشرح أهداف الحركة وأفعالها. واتبعت كلٌّ من هذه النظريات (حمراء كانت أو بنيةً أو سوداء) أسطورةً واحدة؛ وهي أعمق أساطير القرن العشرين قاطبةً. لم تعد الأسطورة أسطورة بروميثيوس، ولم تعد أسطورة إبراهيم. كانت تلك أسطورةً جديدةً كليةً، كانت توراتيةً ولم تكن من العهد القديم أيضاً.
لست أول من يخوض في أقوى الأساطير الحديثة أو من يعلق عليها. فقد حلّلها نورمان كوهن في دراسته الكلاسيكية للعصور الوسطى المتقدمة "سعياً خلف العصر الألفي". وعاد أندريه غلوكسمان إلى الأسطورة عينها في كتابه الذي تناول نهاية الحرب الباردة "الوصية الحادية عشرة". ولكن، كيف السبيل إلى تفسير ذلك؟ يبدو أن الإدراك الكامل لقوة هذه الأسطورة وطبيعتها يتجاوز العقلانية الحديثة، كما لو أننا (حتى الآن) عمي البصيرة عن الأفكار التي تحكم زماننا. والأسطورة، على أية حال، هي ما تجده في أغرب الكتابات وأكثرها إدهاشاً، إنه كتاب "الثورة" للقديس يوحنا المقدس. وهو يقول إن ثمة شعباً هو شعب الله؛ وأن هذا الشعب يتعرض لهجوم. ويأتي هذا الهجوم من الداخل. وهو هجومٌ هدام يشنه سكان بابل الأثرياء الذين لديهم أشياء من مختلف أنحاء العالم، والذين يتاجرون بالذهب والفضة والجواهر واللآلئ والكتان والقرمز والحرير والعاج والزعتر والأخشاب الثمينة والنحاس والحديد والرخام والقرفة والعطور والمراهم والبخور والنبيذ والزيت والطحين والقمح والشوندر والأغنام والخيول والعربات، فضلاً عن متاجرتهم بالعبيد وبأرواح الناس.
غرق سكان هذه المدينة في الأحقاد. ولوثتهم مومس بابل (للقصة مكونها الجنسي أيضاً). إن التلوث ينتشر في شعب الله. ومثله ينتشر ذلك الهجوم من الداخل. لكن ثمة هجوماً من الخارج أيضاً، وهو يأتي من البعيد، من قوى الشيطان الذي يعبدونه في معابده. لكن هذه الهجمات من الداخل والخارج ستلقى مقاومةً عنيفة. وسوف تقع معركة هرمجدون. وسيجري القضاء على أهل مدينة بابل الملوثة، ومعهم أحقادهم. وسوف تدحر قوى الشيطان الآتية من عالم الغيب. وسيكون دمارٌ مخيف. لكن، ما من شيءٍ يبعث على الذعر: فلن يدوم الدمار إلا ساعةً. وعندما تنتهي تلك الإبادة، ستقوم مملكة المسيح وتدوم ألف عام. وسوف يعيش شعب الله في خضوعٍ لله لا تشوبه شائبة. تلك هي الأسطورة النقيض. ويبين كامو أن أفكار التمرد الآثم بدأت بين الشعراء، وكذلك فعلت فكرة إعادة رواية هذه الأسطورة النقيض في نسخها العصرية. ويمكنك رؤية الأفكار الأساسية وبعضاً من تلك الروح لدى ريمبود؛ بل لعلها أوضح لدى روبن دارفو أعظم شعراء أمريكا اللاتينية. فمنذ 1905 صور دارفو شعب الله، وصور وحوشاً أسطورية وبزوغ شموس الألفية، وعبّر عن أفكاره بنبرةٍ جازعة بدت هستيريةً كما يعبر بودلير. إن شعب الله في نسخة دارفو هم أبناء ذئبة روما:
سيشهد العرق اللاتيني فجر مستقبلٍ عظيم،
وفي عاصفةٍ من موسيقى العلياء،
ستحيي ملايين الشفاه ذلك النور الرائع الذي يأتي من الشرق.
لقد صارت صورة فيض الدماء، وصورة الوحوش الشرسة الماضية صوب بيت لحم، وما شابه ذلك مَعْقِد المخيلة الشعرية في باكورة القرن العشرين. لكن الأسطورة الكاملة في نسختها الحديثة، قصة بابل وهرمجدون بصفتها روايةً كاملة لا مجرد مجموعة من الصور المفزعة التي تلائم الشعراء، لم تتكون إلا في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. ولم يكن هذا على صورة شعرٍ أو أدب، بل على هيئة نظريةٍ سياسية. فقد اشتغل عظماء منظري الحركات السياسية في القرن العشرين الجديد، واحدٍ تلو الآخر، على إعادة صياغة الأسطورة فأنتج كل منهم نسخةً بدت مخالفةً تماماً لما أنتجه غيره. لكن، وكما يبين غلوكسمان، فقد التزمت كل واحدةٍ من هذه النسخ الحديثة عن الأسطورة القديمة التزاماً شديداً بقدرٍ أو بآخر بالشكل والنسيج العامين لذات الأصل التوراتي.
وقد وُجد شعب الله على الدوام؛ ذلك الشعب الذي تتعرض حياته الجمعية المسالمة للخطر. وكان ذلك الشعب هو بروليتاريا الجماهير الروسية (في نظر البلاشفة والستالينيين)، أو أبناء ذئبة روما (في نظر فاشيي موسوليني)، أو الإسبان الكاثوليك ومقاتلو المسيح الملك (في نظر كتائب فرانكو)، أو العرق الآري (في نظر النازيين). ووُجد أيضاً الهدامون من بين سكان بابل ممن يتاجرون بالسلع من مختلف أصقاع الأرض ويلوثون المجتمع بكراهيتهم. وكان هؤلاء هم البرجوازيون والكولاك (في نظر البلاشفة والستالينيين)، وهم الماسونيون والكوزموبوليتانيون (في نظر الفاشيين وكتائب فرانكو)، وعاجلاً أو آجلاً، هم اليهود دائماً (في نظر النازيين، وغيرهم من الفاشيين وإن بدرجة أقل، بل في نظر ستالين في آخر المطاف أيضاً).
وكان سكان بابل الهدامون يتلقون دائماً مساعدة قوى الشيطان من عالم الغيب. وكانت قوى الشيطان تضغط دائماً على شعب الله من جميع الجهات. كانت تلك قوى الحصار الرأسمالي (في نظر البلاشفة والستالينيين)، وكانت أيضاً كماشة الضغط التكنولوجي السوفيتي والأمريكي التي تعصر حياة ألمانيا بين فكيها (وفق تفسير هيديغر النازي)، أو هي المؤامرة اليهودية العالمية (في نظر النازيين أيضاً). لكن، ومهما يكن الحاضر مزعجاً وفاسداً، فإن مملكة الله هي التي تسود في المستقبل. والمستقبل هو عصر البروليتاريا (في نظر البلاشفة والستالينيين)، أو عصر إحياء الإمبراطورية الرومانية (في نظر الفاشيين)، أو عصر حكم المسيح الملك تحديداً (في نظر كتائب فرانكو)، أو عصر الرايخ الثالث، وهو إحياء الإمبراطورية الرومانية في نسخةٍ آريةٍ شقراء (في نظر النازيين).
ومن شأن المملكة القادمة الجديدة أن تكون نقيةً دائماً: مجتمعٌ تطهر من ملوثاته وأحقاده. وكان من شأنها أن تمثل نقاء العمل من غير استغلال (في نظر البلاشفة والستالينيين)، أو نقاء العظمة الرومانية (في نظر الفاشيين)، أو نقاء الفضائل الكاثوليكية (في نظر كتائب فرانكو)، أو هي النقاء البيولوجي للدم الآري (في نظر النازيين). ولا يهم هنا ما اتخذته هذه المكونات الكثيرة للأسطورة من أسماء، فالمملكة الجديدة تدوم ألف عامٍ دائماً. أي أنها ستصبح مجتمعاً كاملاً خالياً من العيوب أو المنافسة أو الاضطراب المفضي إلى التغيير والتطور. وأما بنية تلك المملكة النقية الأبدية غير المتبدلة فهي عين البنية دائماً. وسوف تكون دولة الحزب الواحد (بالنسبة للبلاشفة والفاشيين وكتائب فرانكو والنازيين). إنها مجتمع تستبعد بنيته ذاتها أي تحدٍّ لشكله أو وجهته. وهي مجتمعٌ أفلح في إنجاز وحدة بني البشر النهائية. وكانت كل واحدةٍ من تلك الدول تُحكم بالأسلوب عينه من قبل رمزٍ عظيمٍ حي هو القائد.
وكان القائد سوبرماناً. كان عبقرياً فاق كل عبقري. وكان رجلاً على صهوة جواده؛ وكان بادي الجنون في كلامه وسلوكه، وكان يجسد بجنونه أعمق نوازع معاداة الليبرالية، تلك النوازع التي كانت ثورةً ضد العقلانية. ولأن القائد يجسد قوةً تفوق قوى البشر، فقد كان يطوّع قوى التاريخ (في نظر البلاشفة والستالينيين)، أو قوة الله (في نظر الفاشيين الكاثوليك)، أو قوة العرق البيولوجي (في نظر النازيين). ولأن شخص القائد يمارس سلطةً تفوق مستوى البشر، فقد كان مستثنى من قواعد السلوك الأخلاقي. وقد أظهر هذا الاستثناء، وبالتالي طبيعته شبه الإلهية، وذلك تحديداً عبر التصرف بطرقٍ تثير الصدمة.
كان لينين النموذج الأول لذلك القائد. وهو لينين الذي كتب منشوراته ودفاتره الفلسفية بثقةِ رجلٍ يؤمن أن أسرار الكون طوع أصابعه؛ وهو من أقام ديناً جديداً عجيباً اتخذ كارل ماركس إلهاً له؛ وهو من حنطوه بعد موته كأنه أحد الفراعنة، وراحت الجماهير تعبده. لكن الدوتشي لم يكن بأقل منه سوبرمانيةً. وكان ستالين صنماً. أما هتلر، فقال عنه هيديغر وعيناه تكادان تخرجان من محجريهما: "حسبكم أن تنظروا إلى كفيه".
كان كلٌّ من هؤلاء القادة إلهاً. وقد عرفت كلُّ حركةٍ في كل بلد إلهاً من هذا النوع: شخصٌ مخبول، شديد الذكورة، كليُّ القدرة؛ إلهٌ يبعث الرعشة في نفوس تابعيه المتعبدين، وبطلٌ يغطي الدم راحتيه، شخصٌ تحرر من القيود المذِّلة التي تفرضها الأخلاق العادية، شخصٌ يستطيع التحديق في الحياة والموت باتزانٍ ملؤه السأم، شخصٌ لا يقيم شأناً للحياة ويستطيع الأمر بإعداماتٍ جماعية من غير سببٍ على الإطلاق أو لأتفه الأسباب طراً. ولأن القائد كان عدمياً دائماً، كان نيشاييف، وكان ستافروجين من "الشياطين" (باستثناء أنه لم يعد هامشياً تافهاً ضيق النطاق يثير الاحتقار في النفوس). وبخلاف ذلك، شهد القرن العشرين ظهور نيشاييفات وستافروجينات في جميع بلدان أوروبا القارية. وقد أمسك هؤلاء بالسلطة وقادوا جيوشاً وشرطةً وحركاتٍ شعبيةً. وقد سلك كلٌّ من هؤلاء القادة مسلك الإله، وتصرف بما يتصرف به الإله: إنه الموت.
كان هذا، وفي جميع نسخ الأسطورة، لأن مملكة الله لا يمكن تحقيقها قبل قيام حرب هرمجدون، أي قبل حمام الدم الذي يبيد كل شيء. وكانت تلك الحرب، في مداها الكوني وفي وحشيتها القاتلة، بسبيلها لأن تشبه الحرب العالمية الأولى. وكانت بسبيلها لأن تكون حرب الطبقات (في نظر البلاشفة والستالينيين)، أو حرباً صليبية (في نظر الفاشيين)، أو حرباً عرقية (في نظر النازيين). وكانت بسبيلها لأن تكون حرباً لا تعرف الرحمة، معركةٌ على غرار معركة فردان تنتج الموت على غرار الإنتاج الصناعي. إنها حرب إبادة. "يحيا الموت"، هكذا هتف أحد جنرالات فرانكو. كان الموت هو النصر بمقتضى المخيلة الجديدة.
أعلنت هذه الحركات الأوروبية العديدة عن كثيرٍ من البرامج واسعة الخيال من أجل تقدم البشر. وكانت تلك البرامج غير عمليةٍ دائماً في نسخها الكاملة: برامج للمجتمع كله لم يكن وضعها موضع التطبيق ممكناً. لكن الموت كان عملياً. كان الموت الإنجاز الثوري الوحيد الذي يمكن تحقيقه فعلاً. كانت وحدة البشر ومملكة النقاء والأبدية أهدافاً عزيزة المنال وفق أي منظورٍ تقليدي أو واقعي. لكنها كانت يسيرة المنال كلها في صيغة الموت الجماعي. إذن، فقد أصدر القائد أوامره. "وذُبحت البقية بسيف من كان على صهوة جواده....".