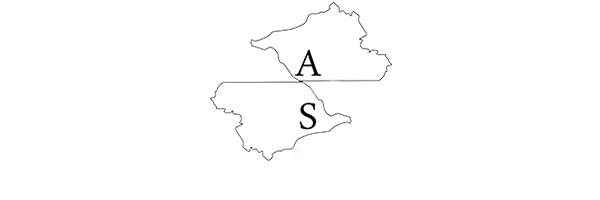الفاشية.؟
جزء من كتاب للعالم البريطاني: ميشيل مان
إعداد: مركز آسو للدراسات
أُعرِّف الفاشية من حيث القيم والأفعال، والمنظمات الأساسية التي حملها أو مارسها أو انخرط فيها الفاشيون. وبصورة عامة فإنَّ الفاشية هي السعي وراء دولةٍ أمة متعالية ونقية من خلال النزعة الميليشياوية. ويشتمل هذا التعريف على خمسة مصطلحات أساسية تتطلب مزيداً من التفسير. ويحتوي كلٌّ منها على ضروب من التوتر الداخلي:
أولاً: الأمة أو القومية:
كما يعلم الجميع، فإنَّ لدى الفاشيين نوعاً من الالتزام العميق والشعبوي بأمةٍ "عضوية" أو متكاملة تماماً، الأمر الذي ينطوي على إحساس قويٍّ إلى حدٍّ بعيد بـ "أعداء" هذه الأمة، سواءٌ في الخارج أم (خاصةً) في الداخل. ولا يبدي الفاشيون سوى أقلّ القليل من التسامح تجاه التنوّع الإثني أو الثقافي. لأن ذلك كفيل بأن يخرّب وحدة الأمة العضوية الكاملة. والعدوان على الأعداء الذين يُفتَرَض أنهم يهددون تلك الوحدة العضوية هو المصدر الأصلي لتطرّف الفاشية. والقومية المختلطة عرقياً أثبتت أنها أكثر تطرفاً، حيث يكون العرق فيها سمة منسوبة. فنحن نولد مع هذه السمة، ولا يمكن أن يزيلها سوى الموت. ولذلك كانت القومية العِرقيّة النازية مسكونةً بفكرة "النقاء" وأثبتت أنّها مميتةٌ أكثر من القومية الثقافية الإيطالية التي كانت تتيح عموماً لأولئك الذين يظهرون القيم الحقّة والسلوك الحقّ أن ينضمّوا إلى الأمة.
أما فكرة "البعث"، التي اعتبرها غريفن السمة الأساسية للفاشية، فأراها سمة للقومية بصورة عامة، بما في ذلك القوميات المعتدلة كما هو الحال مثلاً في القومية الإيرلندية، أو الليتوانية، أو في زيمبابوي. ولأن الأمم حديثةٌ عملياً (باستثناء حالة أو حالتين) لكنّ القوميين يدّعون القدم، فإنَّ هؤلاء القوميين يحلّون هذا التناقض من خلال فكرة الإحياء أو البعث لأمة قديمة مزعومة، لكنها أمة تكيّفت الآن مع العصور الحديثة. وفي مثل هذه الحالات فإنَّ أسطورة التواصل تعود إلى عظمة الملوك السابقين والدّوقيات الكبرى والبلد العظيم، دون أن يكون أيّ من هذه الأشياء قائماً بالفعل.
ثانياً: الدولة:
ويشتمل ذلك على هدفٍ وشكل تنظيمي. فالفاشيون يعبدون سلطة الدولة. ويزعمون أن الدولة السلطوية الجامعة يمكن أن تحلّ الأزمات وتأتي بالتطور الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي كما يؤكّد غريغور (1979). ولأنّ الدولة تمثل أمة يُنْظَر إليها على أنها عضوية في جوهرها، فإنَّ هذه الدولة تحتاج لأن تكون سلطوية تجسّد إرادة واحدة متلاحمة تعبّر عنها نخبة حزبية تتمسّك بـ "مبدأ القيادة". وقد اعتاد الباحثون على التأكيد على صفة "الكليانية" التي تَسِم الأهداف والدول الفاشية؛ ولا يزال برلي (2000) وغريغور (2000) يفعلان ذلك ويتّفق آخرون على أن الهدف الفاشيّ هو تغيير "الكلّي" للمجتمع، لكنهم يؤكّدون على نوع من الردّة أثناء المسيرة. ويرون أن الدولة الفاشية المرغوبة هي دولة مبهمة أو متناقضة، تشتمل على أحزاب متنافسة، وعناصر تعاونية أو نقابية، وغالباً ما يلاحظون أن الفاشية في السلطة تتّسم بدولة ضعيفة إلى حدّ مدهش. وقد فصّلوا في النزعة الانقسامية التي ميّزت نظام موسوليني (ليتلون 1987) و"التعددية" أو حتى "الفوضى" التي ميزت النظام النازي (بروزات 1981؛ كيرشو 2000). ولذلك كانوا محقين في تردّدهم إزاء وصف الفاشية بصفة "الكليانية" فالأنظمة الفاشية، مثل الأنظمة الشيوعية تنطوي على ديالكتيك بين "الحركة" و"البيروقراطية"، بين "الثورة الدائمة" و"الكليانية" (مان 1997) ويمكن أيضاً أن نتبيّن توتراً بين النقابية المنظمة على الطريق الإيطالية والتفضيل النازي لديكتاتورية "تعدّدية" ورخوة. ونلاحظ في كل هذه الأنظمة ميولاً إلى دولة بيروقراطية أحادية يعترضها النشاط الحزبي والميليشياوي والصفقات التي تُعقَد مع النخب المنافسة. وبذلك تكون الفاشية أكثر كليانية في أهداف التغيير منها في الأنظمة الفعلية التي تقيمها.
ثالثا: التعالي:
يرفض الفاشيون الأفكار المحافظة التي ترى أن النظام الاجتماعي القائم متجانس في جوهره. كما يرفضون الأفكار الديمقراطية الليبرالية والاجتماعية التي ترى أن الصراع بين جماعات المصالح هو سِمة أساسية من سمات المجتمع. ويرفضون الأفكار اليسارية التي ترى أن التجانس لا يمكن تحقيقه إلا عبر الإطاحة بالرأسمالية. ويأتي الفاشيون من صفوف كلٍّ من اليمين والوسط واليسار السياسي على حد سواء، ويستمدّون دعماً من جميع الطبقات (ويبر 1967: 503). وهم يهاجمون كلاً من رأس المال والعمل فضلاً عن المؤسسات الديمقراطية الليبرالية التي يزعمون أنها تفاقم شقاءهم. أما الدولة الأمة الفاشية فسوف تكون قادرة على أن "تتعالى" فوق الصراع الاجتماعي، فتقمع أولاً أولئك الذين يولّدون الشقاء ب"ضرب رؤوسهم ببعضها بعضاً" ثم تدمج الطبقات وجماعات المصالح في مؤسسات تعاونية تابعة للدولة. ويبدو مصطلح "الطريق الثالث"، الذي يفضّله إيتول، أضعف بكثير من أن يعبّر عن هدف التغيير الثوري هذا، وأقرب بكثير من أن يتبنّاه سياسيو الوسط مثل توني بلير. ولذلك لا يقتصر الأمر على تسويةٍ أو جمعٍ بين أفضل ما في الإثنين (كما يقول إيتوِل). ذلك أنه يشتمل على خلق مزعوم لإنسان جديد.
ولقد استجابت الفاشية جزئياً لأزمة الرأسمالية (كما يقول الماديون)، لكنها قدّمت حلاً ثورياً تفترض أنَّ من الممكن تحقيقه. وسوف نرى لاحقاً أنّ "الدوائر الانتخابية الأساسية" التي تدعم الفاشية لا يمكن أن تُفهم إن لم نأخذ مطامحها في التعالي والتجاوز على محمل الجدّ، ذلك لأنها أصيلة تماماً على هذا الصعيد. وهذا التعالي يشكّل جزءاً قوياً من إيديولوجية هذه الدوائر، ذلك أنه يقدّم رؤية معقولة وقابلة للتطبيق تمثّل الانتقال إلى مجتمع أفضل. كما يمثّل هذا التعالي جزءاً مركزياً في برنامج الفاشية الانتخابي. ولقد سبق أن رأيت أنّ الإيديولوجيات تكون في قمة قوتها حين تقدّم رؤىً معقولة وإن تكن متعالية لعالم أفضل. وهي إذ ذاك تجمع بين العقلاني وما وراء العقلاني.
ومع ذلك فإن التعالي هو المصطلح الأشد إشكالية وتغيّراً بين المصطلحات الفاشية الأساسية الخمسة. فهو لم يتحقق قط عملياً. وفي الممارسة، مالت معظم الأنظمة الفاشية إلى النظام الراسخ وإلى الرأسمالية. والفاشيون يفتقرون إلى نقدٍ عامٍّ للرأسمالية (بخلاف الاشتراكيين) ذلك أنهم يفتقرون جوهرياً إلى الاهتمام بالرأسمالية والطبقات. وتشكّل الأمة والدولة، وليس الطبقة، مركز الجذب لديهم. وهذا ما يفضي بهم إلى صراعٍ مع اليسار وليس مع اليمين لأنَّ الماركسيين والفوضويين، وليس المحافظون، ينزعون إلى الالتزام بالأممية. لكن الفاشيين، بخلاف اليسار واليمين السياسيين، يمكن أن يكونوا براغماتيين حيال الطبقات، في حال لم يعتبروا هذه الطبقات أعداء للأمة. ولذلك فهم لا يهاجمون الرأسمالية بحدّ ذاتها، بل أنماطاً بعينها وحسب من الحصول على الربح، عادة ما تتمثّل بالرأسماليين الماليين أو الأجانب أو اليهود. وفي رومانيا وهنغاريا، حيث تسيطر هذه الأنماط من رأس المال، كان للفاشية نبرة بروليتارية مميزة. أمّا في غير مكان فكانت الحركات الفاشية نصيرة للرأسمالية. وحين اقتربت من السلطة، واجهت مشكلة خاصة. فعلى الرغم من أملها بأن تُخضِع الرأسماليين لأهدافها الخاصة، فإنها كانت تؤمن بالقدرات الإدارية انطلاقاً من سلطويتها على الرغم من إدراكها أنها تفتقر إلى المهارات التكنوقراطية اللازمة لإدارة الصناعة. ولذلك فقد عقد الفاشيون تسوية مع الرأسماليين. وعلاوةً على ذلك فإن الانقلاب الفاشي الألماني وأكثر منه الانقلاب الفاشي الإيطالي كان مدعوماً من قبل الطبقة العليا. ولم يبدِ موسوليني وهو في السلطة أي رغبة في تصحيح هذا الانزياح إلى الطبقة الحاكمة، مع أن هتلر كان مختلفاً. ولو أنّ نظامه دام أطول، أشكّ في أنّ اقتصاد الرايخ كان يمكن أن يظلّ حاملاً لصفة "الرأسمالي".
غير أنّ الفترة الزمنية القصيرة التي أتيحت للفاشيين كانت كافيةً بحدّ ذاتها لأن يميلوا إلى الرجوع عن مشروعهم الأصلي في التعالي على الصراع الطبقي. ومثل هذه "الخيانة" تؤكّد عليها التفسيرات الطبقية الفاشية كما يؤكد عليها آخرون ممن يشكّلون في صدق أو اتساق القيم الفاشية (كما نجد عند باكستون 1994، 1996). غير أنّ أمر الفاشيين لا يقتصر على الخيانة. فجميع الحركات الفاشية ظلت ممزقة بين "الراديكاليين" و"الانتهازيين"، وهذا ما أضفى على الحركة الفاشية نوعاً من الدينامية وقد تكشّف أحد أشكال ذلك على نحوٍ خاص لدى النظام النازيّ. حيث أدّت هذه الدينامية إلى إزاحة هدف التعالي وليس إلى التخلّي عنه. فقد أراد هذا النظام أن يتعالى على الشقاء والإثني والطبقي، لكنهم لم يتخلصوا سوى من الأعداء الإثنيين حيث ثبت أن التسوية ضرورية مع العدو الرأسمالي. والحقيقة أن انزياح أهداف التعالي هذه قد زادت عملياً من قسوة ووحشية الفاشية، ليس في ألمانيا فقط بل في إيطاليا.
رابعاً: التطهير:
نظراً لرواية الفاشيين إلى خصومهم على أنهم "أعداء"، فقد كان من الواجب إزالتهم وتطهير الأمة منهم، الأمر الذي مثّل عدواناً فاشياً تمت ممارسته بالفعل. ومن المحزن أننا عدنا مؤخراً للاعتياد على "التطهير الإثني"، مع أنَّ التخلّص من الأعداء السياسيين كان أقلّ انتشاراً في أواخر القرن العشرين. والقوميون العضويون عادةً ما يعتبرون الأعداء الإثنيين الأصعب من حيث التعايش معهم، لأنّ الهويات السياسية يمكن بذلك أن تتغير بسهولة. فالشيوعيون يمكن أن يُقمَعوا، وأن يُقتل بعضهم، وإذا ما تابوا، فيمكن قبول معظمهم في الأمة. ولذلك، فإن التطهير السياسي غالباً ما يبدو وحشياً، لكنه يخفّ ويهدأ ما إن "يستسلم العدو" ويتمّ تمثّله في الأمة. أما التطهير الإثني فغالباً ما يتصاعد، لأنّ "العدو" قد لا يمكن تمثّله. ومعظم الفاشيات تجمع بين التطهير العرقي والسياسي، على الرغم من اختلاف الدرجات. وحتى "أعداء" النازية المزعومين كانوا قد ظهروا في خليط من الإثني والسياسي، الأمر الذي تظهره عبارة "البلاشفة – اليهود". وكانت حركات مثل الفاشية الإيطالية أو القومية الإسبانية قد حدّدت معظم أعدائها بمصطلحات سياسية أساساً. ولذلك كانت النازية الإثنية التي تقف في أقصى هذا الطيف أكثر وحشية من مثيلتها الإيطالية.
خامساً: النزعة الميليشياوية:
شكّلت هذه النزعة قيمة أساسية وشكلاً تنظيمياً بالنسبة للفاشية، وقد نُظِرَ إليها على أنها "شعبية" أي على أنها تمثّل إرادة عفوية من الأسفل، لكنها كانت أيضاً نخبوية، يُزعَم أنها تمثّل كلية الأمة. وقد رأى بروكر (1991) أنّ قيادة الحركات الفاشية هي السمة التي تتحدّد بها هذه الحركات التي من المؤكّد أنها كانت تنظر إلى قيادتها التي حنكّتها المعارك كمثالٍ ونموذجٍ للأمة العضوية والإنسان الجديد. أما العنف فكان أساس "الراديكالية" التي اتسمت بها الفاشية. فكانت تطيح بالأشكال الشرعية والقانونية عن طريق القتل. فمن خلال هذا القتل يحقق البشر التعالي الطبقي، عبر "ضرب الرؤوس ببعضها بعضاً". وهذه النخبوية والتراتبية تسيطر بعد ذلك في الدولة السلطوية التي تُقام. وما من حالةٍ واحدة كانت فيها الحركة الفاشية مجرّد "حزب". بل إنَّ الفاشيين الإيطاليين لم ينتظموا لسنوات طويلة إلا في ميليشيات. وعلى الدوام كانت الفاشية موحّدة الزيِّ، مسلحة وخطيرة تخرج في المسيرات والمظاهرات وتنزع جذرياً استقرار النظام القائم.
وما يميز الفاشيون جوهرياً عن ديكتاتوريات العالم العسكرية والملكية الكثيرة هو هذا "الصعود من أسفل إلى أعلى" والخاصية العنيفة التي تميّز ميليشياتها. ومثل هذا الأمر يمكن أن يحظى بالشعبية، سواء في الانتخابات أم بين النخب.
يصوّر الفاشيون عنفَهم دائماً على أنه "دفاعي"ّ لكنه "ناجح" يهزم الأعداء الذين هم المصدر الحقيقي للعنف. صحيح أن من صدّق ذلك ليس الجميع، لكن الكثيرين صدّقوه، وهذا ما زاد في شعبيتهم، وأصواتهم، وجاذبيتهم بالنسبة للنخب. وهكذا وفّرت لهم النزعة الميليشياوية مقاربة مميزة للديمقراطية الانتخابية والنخب القائمة، مع أنهم كانوا يحتقرون كلتاهما. وينبغي النظرة إلى النزعة الميليشياوية دوماً على أنها توأم مصدرين أساسيين آخرين من مصادر القوة الفاشية: في الصراع الانتخابي وفي تحطيم النخب. فالنزعة الميليشياوية – التي تحبس الفاشيين وتقهر خصومهم، وتستجلب دعم الحياديين أو احترامهم – هي التي مكّنت الفاشيين من أن يقوموا بما يزيد كثيراً على مجموع ما فعله أفرادهم. وهكذا كانت النزعة الميليشياوية عنفاً، لكنها كانت على الدوام أكثر بكثير من مجرد العنف. صحيحٌ أنه لم يلزم الفاشيين كثير من العنف للانقلاب حين نعني بذلك السيطرة على جيش الدولة. فالميليشيا لم تكن مرادفاً للقوة العسكرية. وكان يمكن للفاشيين أن يقوموا بانقلابهم بمجرّد أن يحيّدوا القوة العسكرية عبر لجوئهم إلى الجنود أنفسهم.
ولقد جعل تضافر هذه الخاصيات من الفاشيين "ثوريين" على نحوٍ واضح، وإن يكن ليس بالمعاني اليسارية واليمينية التقليدية. فليس من الصائب أن نصفهم بأنهم "ثوريين يمنيين" كما يفعل البعض. كما يعني هذا التضافر أنَّ تلك الحركات يمكن أن تكون متفاوتةً في فاشيتها. حيث يمكن لنا من حيث المبدأ أن نتصوّر حركات فاشية (كلٌّ منها مزيدة على نحوٍ واضح) في وسط فضاء خماسيّ الأبعاد، مع أنني أعترف بأن هذا يتجاوز ما أملكه من مهارات التمثيل. كما أنه يتعدّى قدراتي هنا بين الحركات الفاشية والحركات الشيوعية على هذه الأصعدة، على الرغم من بعض التشابهات الواضحة فضلاً عن بعض الاختلافات. فكلتاهما رؤيتان بديلتان للحداثة، وإن كانتا رؤيتين مخففتين.
والحال، أنَّ من يقاربون الفاشية مقاربة طبقية تركّز في معظمها على "الأساس الاجتماعي" والوظائف الموضوعية إنّما تتجاهل معتقدات الفاشيين أنفسهم، وتنظر إلى الفاشية "من الخارج"، من منظور لا يهتمُّ كثيراً بالفاشيين أنفسهم، الذين ينفرون من النظريات الطبقية كما ينفرون من كلّ نزعة مادية. ويركزون على غير مكان. ولقد سبق لي أن قدّمتُ نظرية طبقية عن الفاشية الإيطالية (مستمدة من سالفاتوريلي)، ثم قدّمت رواية موسوليني عن السبب الذي دفعه إلى اعتناق الفاشية. وبدا أنهما يناقشان أشياء مختلفة تماماً. ولعلَّ الآخرين يعرفون أفضل من موسوليني ما كان على وشك القيام به، أو لعله كان يشوّه الحقيقة (ولقد كان كذلك حقاً بصورة جزئية) لكن التباعد يظلّ لافتاً، خاصةً بالنسبة لعالم الاجتماع. ذلك أن معظم علماء الاجتماع يتمسكّون بالقول: "إذا ما رأى البشر الأشياء على أنها واقعية، فهي واقعية في عواقبها". وإذا ما كان الفاشيون ليعتقدون أنهم يسعون وراء أهداف معينة فإن لهذا الاعتقاد عواقبه بالنسبة لأفعالهم ولا يمكن الاكتفاء بمجرّد تجاهله.
وثمّة صعوبة أخيرة تواجه مقاربة الفاشية مقاربة تقوم على المصالح الطبقية، فالفاشيون يحثّهم شعور شديد بضرورة الكفاح لتطهير أفقهم من "الأعداء"، ولذلك ينغمسون في عدوان وحشيّ وعنف مريع وهذا العدوان والعنف لا يعود عليهم عادةً بالنفع الماديّ. والفاشيون عدوانيون جدّاً إذا ما تعلّق الأمر بصالحهم الخاص، الأمر الذي يظهر بصورة خاصة في توقهم البالغ إلى الحرب. وهم واثقون تاريخياً مما يمكن للإنسان الجديد أن يحقّقه. ومع أنّ المصالح المادية تدفع بعضهم ضدّ اليهود وسواهم من "الأعداء" (ومن هنا ذلك الحضور الكلي للسلب والنهب)، إلا أنّ الإبادة تبقى مسألة أخرى. فهي لم تحدث سوى الأذى المادي لألمانيا (ولم يحسّ بها سوى جنرالات الجيش وضباط المخابرات المخوّلين بالتخطيط الاقتصادي). والحال أنّ الجمع الفاشيّ بين الأخلاق، والعدوان، والقتل، يطيح في النهاية بالنظريات القائمة على المصلحة المادية فالفاشيون كانت تدفعهم كلٌّ من العقلانية القيمية والعقلانية الأداتية. وفي النهاية سيطرت هذه العقلانية الأخيرة وأدّت إلى دمارهم.
أما فشل مفسّري الفاشية القوميين على هذا الصعيد فمسألة أخرى. فلقد أخفقوا في استكشاف وفهم الدوائر الانتخابية الأساسية للفاشية بخلاف المنظرين الطبقيين وهم يركّزون على محتوى الإيديولوجيا الفاشية ويتجاهلون قاعدتها الاجتماعية، مع أنهم في بعض الأحيان يكتفون باستعارة التفسير الطبقي واللافت أنهم يقولون إنّ قيماً مثل القومية أو العنصرية أو العسكرية هي قيمٌ "برجوازية" أو "برجوازية صغيرة" (موس 1964، 1966؛ كارستن 1980: 232). وما يحيّرني هو لماذا ينبغي أن نفكّر في هذه القيم على أنها قيم تعود إلى الطبقة الوسطى بصورة مميزة. ويبدو أنّ كثير من الباحثين لا تروق لهم البرجوازية الصغيرة، ولعلها الخلفية الطبقية التي يحاولون أن يهربوا منها هم أنفسهم. بل إن بعض المنظرين غير الطبقيين يبدون مسكونين بفكرة الطبقة. وثمّة كتبٌ تدّعي تقديم "صوراً اجتماعية" لأعضاء الحزب النازيّ وناخبيه يتبيّن أن 90% منها تدور حول المهنة والطبقات (مثلاً، كاتر 1983؛ منشتاين 1988)، كما لو 90% من هوياتنا الطبقية تخلعها علينا طبقتنا المهنية!
ويقدّم باين (1995) أشمل مراجعة لخلفية الفاشيين. فهو يستكشف بإسهاب خلفياتهم الطبقية. كما يلاحظ بشيء من الإيجاز سماتهم الاجتماعية الأخرى ذات الصلة، كالفتوّة والذكورة، وكثرة الخلفيات العسكرية، والتعليم العالي، والدين، والمنطقة (أحياناً). لكنه لا يحاول أن يربط سوى المعطيات الطبقية بالنظريات العامة في الفاشية. ويتعامل مع بقية المعطيات الطبقية بالنظريات العامة في الفاشية. ويتعامل مع بقية المعطيات كتفاصيل تزيد من تعقيد الصورة دون أن يحاول تنظيرها. أما لينز (1976) فكان قد قدم تحليلاً باكراً ممتازاً لخلفيات الفاشيين، من حيث مهنهم، وطوائفهم، ومناطقهم، وأديانهم" وأعمارهم وجنسهم، وما إلى ذلك. غير أنّ المحيّر أنه يخفق (على الرغم من كونه عالم اجتماع متمكّن) في أن يجد نماذج تشكّل أساساً لمثل هذه الهويات المتنوعة في الظاهر. وعلى الرغم من أنّ هؤلاء الباحثين يرون الفاشية كقومية متطرفة، فإنهم لا يحاولون أن يحدّدوا دوائرها الانتخابية القومية الأساسية. فثمة هوّة واسعة بين الإيديولوجيا والقاعدة الاجتماعية. ويمكن أن نملأ هذه الهوّة بمعرفتنا بدوائر الدعم الميلشياوي إلى جانب الدوائر الطبقية. فالنظريات الطبقية تشتمل على قدر كبير من الحقيقة. والفاشية تستعير بكثرة من الإيديولوجيات والمنظمات الطبقية، ويسكنها تهديد "البلاشفة"، فضلاً عن حساسيتها تجاه المصالح الطبقية. ولقد كان كيتشن صائباً حين قال: علينا أن نفهم قاعدة الفاشية الاجتماعية ووظائفها. غير أنّ "الاجتماعي" لا ينبغي أن يتطابق مع "الطبقي". ودعونا نتفحّص بإيجاز الأوضاع الاجتماعية التي تتجاوب معها الفاشية.