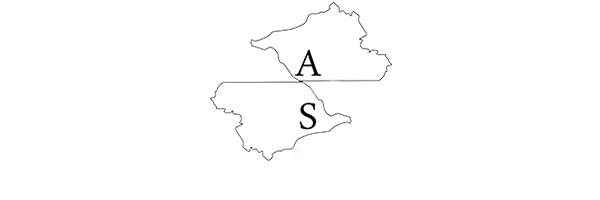لماذا لم تصبح سوريا وطنا؟
إبراهيم خليل
واحد من أهم الأسئلة التي قضى معظم السوريين وقتاً طويلا يتجنبون الخوض فيها وانحازت النخبة الناطقة إلى الغمغمة والرد بكلمات عامة فضفاضة أو بشعارات ديماغوجية شعبوية لا دلالة لها سوى أنها محاولات فاشلة للتهرب من الإجابة أو السكوت على مبدأ "قل أي شيء مهما كان فارغاً ولكن لا تقل الحقيقة ولا تقل لا أعرف".
ظهرت أهمية هذا السؤال الكبير ومحوريته بشكل خاص عقب الأحداث التي شهدتها البلاد في آذار 2011 حين وجد جميع السوريين أنفسهم أمام حقيقة مفاجئة هي أن "دولة سوريا" أو "الجمهورية السورية " أو "الجمهورية العربية السورية" فشلت أن تتحول, بعد مرور أكثر من سبعين عاماً على الاستقلال, إلى وطن جامع لعموم ساكنيها سوى في المسلسلات والأفلام والأشعار والأغاني والخطابات.
تضم سوريا كأي بلد في العالم, بل كأي رقعة على وجه الأرض, تنوعاً سكانياً على أكثر من صعيد، ديني ومذهبي وقومي وقبلي ولغوي ولهجوي وطبقي. وفي بلد كهذا لا يحتاج الأمر إلى عبقرية للوصول إلى أن نظام حكم علماني ديمقراطي لامركزي هو السبيل الوحيد ليس فقط لتقدم هذا البلد ولكن لبقائه واستمراره. ولكن ما حدث هو أن الحكومات "الوطنية" المتعاقبة قد عجزت تماماً عن تقبل تلك الاختلافات وصهرها ضمن بوتقة هوية وطنية واحدة - كما هي الحال في معظم دول العالم المتحضِّر - وذلك لأسباب كثيرة لعل أهمها:
- نزعة الوحدوية المتأصلة روحياً: تحت تأثير التراث الإسلامي والتاريخ الإسلامي خاصة الذي غذى نزعة وحدوية إمبريالية تتكئ على تصورات ذهنية حالمة عن إمبراطورية سالفة موحدة تحت لواء واحد في ظل إله واحد ودين واحد وحاكم واحد وهوية واحدة وثقافة واحدة.
- الافتقار إلى تراث سياسي ديمقراطي معاصر يؤمن بالتعايش: وظهر أثر ذلك عقب الانتقال المباشر من مرحلة الإقطاع إلى مرحلة الدولة الوطنية دون المرور بنقلة رأسمالية خلاقة أو ثورة صناعية أو ثقافية من أي نوع.
وإذا استعرضنا الفئات والشرائح الرئيسة المكونة للوطن السوري المفترض سنجد:
- كردياً محروماً من حمل جنسية وطن يحلم به ومحروماً من جنسية دولة ولد وعاش فيها كل عمره. هذا الكردي نفسه يهاجر (يهرب) إلى أي بلد أوربي فيحصل على جنسيته خلال سنوات قليلة يتمتع بعدها بالمساواة الكاملة أمام القانون مع ملكها أو رئيس دولتها.
الكردي المحروم من الدخول إلى الجيش والوزارات السيادية وغير السيادية وأعلى منصب متاح له هو مدير مدرسة ولكن بعد إثبات ولائه للنظام وعائلة الأسد اكتشف أن العلة ليست في جيناته الوراثية وأن بإمكانه أن يصبح وزيرا أو نائبا في البرلمانات الأوربية بل حتى رئيس دولة ولكن بعيدا عن نظام (وطنه الأم).
- عربياً سنياً في الحضر والبدو: أما في الحضر فهو تاجر أو دكانجي أو موظف أو صنايعي وهو في جميع أحواله ماشي الحيط الحيط لا يتحرك فتراً خارج دائرة عمله أو وظيفته وعليه تحمُّل جرعات غسيل المخ صباحاً في المدارس ومساءً في التلفزيون حتى يخيل إليه أن سوريا مجرد ولاية في دولة كبيرة متخيَّلة اسمها "الوطن العربي" وحتى ينحصر تعريف الوطنية عنده في نقطتين: تمجيد القائد الأسد رمز الأمة العربية وشتم إسرائيل ووصفها بالكيان الصهيوني.
تتوقف المسيرة العسكرية للعربي السني في وطنه عند رتبة العقيد وتتوقف مسيرته السياسية عند رتبة "وزير دولة" تحركه أصابع مدير الاستخبارات العامة أما إذا أثبت أنه أسدي أكثر من الأسد فقد يُمنَح منصباً سيادياً كوزير الداخلية أو الدفاع ولكن تحت رقابتين صارمتين: ولاؤه الداخلي وتجسس موظفيه عليه.
أما العربي السني في البدو فيعيش في عالم آخر ولا يعني له اسم "سوريا" شيئا تقريباً لأن وطنه هو قبيلته التي يدين لها بالولاء، هي عصبيته القومية وهي جغرافيته وهي وطنه الذي يشعر بالغربة إن ألجأته الظروف إلى مرابع قبيلة أخرى.
العربي السني المتدين التقليدي بدوره لا يدين بالولاء لأي وطن أصلاً لأن وطنه هو ديار الإسلام حيثما كانت فدمشق عنده مثل مكة مثل كابول مثل اسطنبول.
- علوياً مع تاريخ طويل من المظلومية على أيدي كهنة الدين السني من خلفاء بني العباس إلى الأيوبيين فالعثمانيين لم يتشكل لديه هذا الشعور وهو يعيش في جباله غير الحصينة مع عاداته وتقاليده العشائرية والمذهبية مع شعور مؤقت بالأمان ناتج عن وجود آل الأسد على كرسي الحكم ولكن مع شعور مزمن وعميق بالخوف والتوجس من احتمال "انتقام سني" مرتقب. أما العلوي الحضري فوطنه السلطة والمال ولا مانع لديه عند الشعور بخطر فقدانهما من تدمير سوريا من بابها إلى محرابها لأن الوطن بالنسبة إليه ساحة معركة كبيرة والهزيمة تعني الفناء.
- درزياً حالته شبيهة بحالة العلويين من حيث المظلومية والانعزال والشعور الدائم بالخصوصية الدينية والغربة عن الدين الرسمي التقليدي المفروض في التعليم والإعلام الرسميين مع فارق أن الدروز متطهرون من جرثومة السلطة (أو تم تطهيرهم منها عنوة عقب محاولة سليم حاطوم الانقلابية) ولذلك فهم أقل عدوانية تجاه المكونات الأخرى وأكثر انغراساً في أرضهم وتعلقاً بمذهبهم.
- مسيحياً سورياً ينظر إلى نفسه كجزيرة صغيرة وسط محيط إسلامي هائج ومضطرب وعنيف على الدوام فيرى أن من الأنسب له ألا يبتعد كثيرا عن الشاطئ وألا يتدخل في أي صراع بين أي نمرين ويراقب الأمور عن بعد جالساً في ظل جدار الكنيسة.
- إيزيدياً كردياً: وربما كان هو الوحيد الذي يمكن وصفه بـ "بالع الموس ع الحدين" فهو قومياً كردي لا ينتمي إلى الأغلبية العربية وهو دينياً إيزيدي ليس مسلماً كأغلبية السكان وليس مسيحياً من أهل الكتاب والذمة بالإضافة إلى قلة عدد الإيزيديين وعدم تمركزهم في بقعة جغرافية بعينها وهذا ما حذف من قاموسهم نهائياً مفردة الوطن وألجأهم إلى المَهاجر الأوربية.
فضلاً عن مكونات قليلة العدد نسبياً من الأرمن والشركس والتركمان والشيشان واليهود وسواهم ممن لديهم أوطان خارج الحدود السورية أصلاً.
والخلاصة أن سوريا لم تصبح وطناً لأنها أديرت بعقلية الثكنة والسوق في بنيتها التحتية وعقلية مزيج من الميتافيزيقيا القومية والدينية في بنيتها الفوقية وغابت تماماً حقيقة أن الوطن هو التعبير المجازي عن الدولة وأن الدولة صناعة بشرية لا تتطلب من مواطنيها قرابة في الدم أو الدين أو حتى في الآراء بل يكفيها تعايش قائم على ثنائية الحقوق والواجبات في بنيتها التحتية وعلى إدارة رشيدة مسؤولة في بنيتها الفوقية. وهذه الخلاصة نفسها قد تصلح جواباً لسؤال آخر هو "كيف تصبح سوريا وطناً؟".