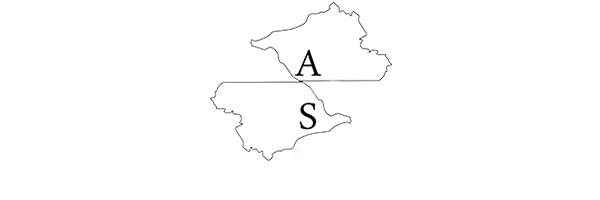مفهوم الإصلاح الديني بين التجاوز والإلغاء
يونس الهديدي
ذ، فلسفة، المغرب.
لا يمكن أن تبدأ أية دورة حضارية دونما نصّ مُؤسِّس، ويبدو هذا جليّاً وبشكل أخص في التاريخ الحضاري الأوروبي. إذ، من الصعب الحديث عن قومة الحداثة علمياً وفكرياً وصناعياً، بعيداً عن المتن الديكارتي أو البيكوني. ولكن أليست حركات الإصلاح الديني "اللوثرية" و"الكالفينية" و"الأنجليكانية" في القرن الساس عشر سابقة على المتن المؤسِس للنهضة الأوروبية؟. إن هذا السؤال الاستنكاري يسائل حركة التاريخ الإسلامي من خلال التساؤل الآتي: هل ألغى النص القرآني بوصفه نصاًّ مؤسِساً الخاصية التأسِيسية في جميع المتون بعدهُ؟ ألا يمكن اعتبار المتن السينوي أو الرشدي أو حتى الصوفي على سبيل المثال- متناً أبطِلت خاصيّة التأسيس فيه؟.
إن قراءة حركة التاريخ الإسلامي، تجعلنا نعيد النظر في تحرير مفهوم الإصلاح الديني. ذلك لأننا نصطدم بتحديد أوروبي يختلف جُملةً وتفصيلاً عن التحديد الإسلامي للإصلاح. فمفهوم الإصلاح يأخذ دلالته أوروبياً من محاولة تجاوز التّغول الكنسي على جميع تفاصيل الحياة، من خلال فرض الوصاية على كل الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الإنسان، بما في ذلك الحق في التفكير والتعبير والمسلك. بينما اتخذ الإصلاح في المفهوم الإسلامي من مرحلة الجاهلية المفترضة دلالته؛ فالإصلاح هو ذاته ما جاء به الدين الإسلامي: } إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ۚ عليه توكلت وإليه أنيب { ( هود : 88). أي، أن الإسلام والتزام تعاليمه الأولى هو الإصلاح عينهُ، فجميع الحركات الإسلامية من قبيل الحركة السلفية بتنويعاتها والحركة الوهابية والحركة الإخوانية بامتداداتها؛ برزت كحركات إصلاحية تروم على حدّ زعم مؤسِّسيها إصلاح ما فسد من تدين المتدينين.
شكّل التمييز الذي وضعناه لدلالة الإصلاح في حركة التاريخ الأوربي الديني من جهة، ودلالته في حركة التاريخ الإسلامي من جهة أخرى، والاختلاف البادي في مرجعية التحديد الخطوة الأولى للإجابة عن الإشكال الذي رسمناه. فالقرآن بوصفه نصا مؤسِّسا ينهض على جذور لاهوتية، يحمل في داخله تضميناً يُرادُ له إبطال جميع النصوص المؤسِسة بعده. فلا غرو أن يشهد بذلك التاريخ الإسلامي إفشالاً مُتعمّداً للمتون الأصيلة، من خلال ترحيلها جغرافياًّ أو كتمها بالحرق أو بتكفير مُصنّفيها، والشواهد على ذلك كثيرة ومتعددة، و يمكن أن نجد صداها في محنة ابن رشد الحفيد، أو في سيرة أبي علي بن سينا، أو خاتمة حياة الحسن بن الهيثم وغيرهم من المؤسّسين للفكر الحديث. وإن، أوردنا الترحيل الجغرافي للمتون لا نتقصد من وراء ذلك إعادة تدوير الاحتفالية التي ترافق الجنائز الحضارية، والتي دأبت المشيخات الدينية في ترديدها على أسماعنا، وإلا لما أبقينا لرونيه ديكارت على حد زعمهم من منجزه الفلسفي إلا الاسم، ولتهمنا العقل الأوربي بدءً من القرن السابع عشر إلى حد الساعة، بتهمة السرقة والسطو على المنجز الإسلامي.
إن افتراض التاريخ الإسلامي لحالة مرجعية تعطي دلالة للإصلاح الذي جاء بعده، وإبطال جميع المتون التي كانت ستؤسِّس عالَماً إسلامياً غير الذي نراه الآن، لهو مربط الفرس في التحديد الصعب التجاوز. إذ، كل محاولة للتجاوز تُصوّر على أنها تجاوز للقرآن. لذلك لا زال الإبطال مستمرًّا و بأشكال عدّة على رغم الوعي النقدي الذي تملّكَه المتأخرون؛ فالمشاريع التجديديّة التي عرفها العالم الإسلامي في أواخر القرن العشرين، عرفت ممانعة قوية ولازالت تعرفها، ومجمل هذه المشاريع لم تكن متونًا مؤسِسة بالمعنى الحرفي للكلمة، بقدر ما كانت محاولات نقدية لمفهوم الإصلاح؛ فمحمد عابد الجابري في نقده للعقل العربي، وتشريح تكوينه. قَدّم لنا رؤية تحديثية تمارس شغبًا تجاوزيًّا على الجمود الفكري الذي عمّر طويلاً هذا العقل، وقُدِم على أنه النموذج النهائي للتحضر، كذلك فعل كل من حسين مروة ومحمد أركون مع قضية التراث وغيرهم من حملة المشاريع التجديدية للعقل الإسلامي.
سواءً تحدثنا عن دلالة الإصلاح بالمفهوم الأوروبي أو عن دلالته بالمفهوم الإسلامي، يظل سؤال توقف التاريخ الإسلامي من خلال الشواهد التاريخية مرتبطاً باعتماد النص القرآني مؤسِساً ولاغياً لكل النصوص بعدهُ، هذا الإلغاء المتمثل بالأساس في الإصلاح منظوراً إليه لا من جهة تحيين هذا النص في الحد الأدنى، وإنما بالعودة إلى معاقله الزمنية والمكانية والوقوع على الأصل فيه، مُكرساً بذلك لإصلاح يتخذ من ثبات (السماء) مرجعية لمتغيرات الأرض. وكذا، من خلال إعلان القرن السابع للميلاد زمناً لمولد النموذج النهائي للتحضر. فإلى أي حد يمكن القبول بإصلاح يتحدد بإشراطية نص أنتج في سياق محدّد وملابسات متنازع عليها؟
إن فاعلية أي متن تصل ذروتها في لحظة تملكه من طرف السلطة، أيا كانت طبيعة هذه السلطة. إذ، يصبح المتن حاملاً لقيمة استعمالية، ويظل في لحظات انفصاله عن سياقات استعماله مجرد متن للتأملات. وذلك هو الذي حصل تماماً مع المتن الإسلامي، فمنذ دخول التاريخ الإسلامي في فترة الأفول الحضاري، أصبح التحضر مقروناً بتلك اللحظة التي شحن فيها المتن بمكونات سلطوية. إذ ذاك، يمكننا أن نفهم دلالة الإصلاح على أنها نزع يمارسه المتن في اتجاه الماضي قصد استعادة السلطة التي سُلبت منه بفعل حركة التاريخ. وليس هذا النّزع المُراد به السلطة إلا المكون الواقعي مُستعاداً مرة أخرى إلى الواقع.
يبرز المتن الإسلامي أمامنا من خلال علاقته بالسلطة ومن ثمّة بالواقع على نحوين؛ النحو الأول يتعلق بلحظة ما قبل تخليق المتن أو إنتاجه أو حتى تنزيله. إذ، يصاحب الإنتاج عملية تعميمية لأحداث معينة على التاريخ العربي إن لم نقل العالمي على المستوى النظري، ونفهم التنزيل على نحو فهم نصر حامد أبو زيد من خلال استبعاده تنزيل النص مبنى ومعنى، والقول بخصوصية النبوة من جهة الإلهام في تحويل الواقع إلى نص مقدس. أما النحو الثاني فيتمثل في استعادة الواقع للمتن بوصفه نظرية عامة تؤطر الحدث في انفلاته من جميع الأبعاد التي صدر عنها، وهذا ما نقصده بسلطة الفعل الموجهة بالتأويل السياسي.
لا مراء في نجاح هذا التأويل، وأسانيد نجاحه تترجمها الحضارة الإسلامية في أوجها، ذاك الأوج الذي بقدر ما كرس لمتن يملك قابلية الإبطال، قدّم نفسه كنقطة مرجعية لأي إصلاح ممكن. فماذا لو تأسست أكثر من حضارة إسلامية بتأويلات مختلفة للمتن الديني؟ هل كان سيكون الإصلاح مؤطرا باستراتيجية التأويل؟ هذا ما حدث بالضبط!
يبدو هذا جليًّا فيما قد نصفه بأزمة تأويل المقدّس، باعتبارها علة التّعدد المذهبي، ولكن التأويل ههنا داخلي ومحاط في جوّانيته بمحرمات التفكيك. أي، بمحرمات الهدم الشامل وإعادة البناء. ولكي نوضح الأمر أكثر، ونخلص في الآن ذاته إلى نتيجة ما، يمكن أن نقول بأن الأسس التي يقوم عليها تأويل المتن لا تخرج عن الاستعمال السياسي له في لحظات الأوج الحضاري.
كاد الإصلاح الديني في أوروبا يقع في الدائرة المغلقة ذاتها؛ دائرة يتمركز محيط الإصلاح فيها على نص ديني مؤسِّس غير قابل للتجاوز، خاصة فيما عرف بمحاولات عقلنة المتن المسيحي، ولكن ما عرفته أوروبا من متون تأسيسية بدأت من اتخاذ الميتافيزيقا أرضية للمعرفة مع ديكارت، مروراً باتخاذ الأخلاق مرجعا للمعرفة مع سبينوزا، انتهاءً بإقصاء نهائي للميتافيزيقا من الابستمولوجيا مع كانط، جعل الأمر يأخذ مساراً تدرّجياً في خلق حوار يقوم على التأثير والتأثر بين الفلسفة والدين. وهذا ما فشل فيه التاريخ الإسلامي، من خلال استبعاده للتدرج ونهج طريق القطيعة والصدمات؛ مما جعل ردود الفعل تبدو عنيفة تجاه المؤسسين، من صلبهم إلى تكفيرهم إلى حرق كتبهم، وأخيرا إلى إجبارهم على تقمص لسان السلطة السياسية.
ترتبط إذن، حركة التاريخ و صيرورة العقل الإنساني، بالتحديد المفاهيمي الذي يؤطرها، ولأننا لا نرتاح للقول الخلدوني الذي يُنهِض الدورة الحضارية على الانتظارية أو على التناوب الدوري، فأننا نعزو للمرجعية التي يقف عليها التحديد الدلالي لمفهوم الإصلاح، وللآلية التي يشتغل بها، الالتباس الحاصل في المفهوم؛ ولا يمكن في نظرنا تحريك مياه البركة الراكدة في العقل الإسلامي، ما لم نعد النظر في المفاهيم المؤطرة له، فكل إصلاح لا ينطلق في تحديده من مرجعية نسبية وفق آلية تدرجيّة، يظل إصلاحاً حذِراً انتظارياً لأنه مؤطر بنموذج مطلق يتمثله النص الديني.