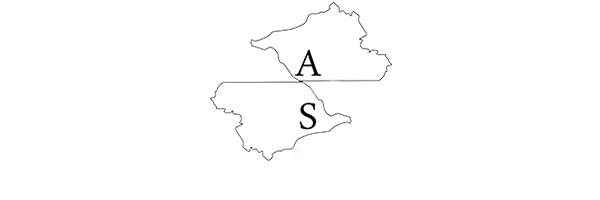FEAR OF FIRE جنديرس 0000/03/21
مور لوران
ارتأيتُ كتابة عنوان المقالة بالإنكليزية لأنّه أشدّ وقعاً على الأذن، فالنار كما هي في العربية، حمّالة أوجهٍ، تنقبض الروح بمعناها وفق الموروث التقليدي، ذاك الموروث المدغم بمفاهيم إسلامية شعبية التأويل، وأحكام شعبوية عالية الخطورة إلى درجة تصل إلى حدٍّ القتل وفق ما سوف نسرده هنا اليوم.
في ليلة النوروز هذا العام، فوجئ الكورد بحادث أليم في جنديرس، تجلى بقتل أربع أشخاص تلاهم خامس متأثراً بجراحه في اليوم التالي، من قبل مسلحين من إحدى فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا. كان هؤلاء الشهداء يحتفون بليلة النوروز بإشعال نارٍ أمام منزلهم كما جرت العادة في الاحتفالات الكردية، ليأتي هؤلاء المسلحون ويطلقوا عليهم النار بكل دم بارد.
بعد أحد عشر يوماً يصدر أخيراً بيان استنكار عن السفارة الأمريكية في سوريا، موضحاً أن هذا يهدد استقرار سوريا، ومطالباً بوقف الهجمات على المدنيين، هذا التأخير بحدّ ذاته يثير الأسئلة عن جدوى حماية مسلحين سوريين يعملون تحت حماية دولٍ بعينها، منتهكين أبسط حقوق الكوردي وهو حق الاحتفال.
لفهم هذا الحادث علينا بالعودة إلى دراسة الوعي الإسلامي الشعبوي، والذي يشكل الخلفية الطاغية للمعارضة السورية المسلحة بكافة فصائلها، وتدرّجها في التطرف الإسلامي، وحساسيتها العميقة من الآخر. ومدى اندماج مفهوم العروبة بالإسلام إلى حدٍّ يماهي بين المسلم غير العربي والكافر. دون أدنى محاولةٍ لفهم الخلفية العميقة لرموز شعبٍ ما، مختلف بالضرورة عن العرب.
حكاية النوروز
ترتبط أسطورة النوروز بملكٍ جائر يدعى أزدهاك حمل ثعبانين على كتفيه، يقتاتان بالدماء الطازجة، وكانت عادة الملك قتل شابين يومياً لإطعام هذين الثعبانين، ولما اقترب دور كاوا الحداد، وبدل أن يهرب إلى الجبال كما فعل الكثر من أقرانه، اختار أن ينظم ثورة، انتهت بأن أردى الملك بمطرقته الحديدية، وكانت النار إشارة انتهاء الظلم. أشعل كاوا النيران ليراها الرفاق في الجبل ويشعلوها على قمته رداً، وتبدأ الاحتفالات بالتخلص من الظلم.
ليست هذه الحكاية الشعبية عبثاً في الوعي الكوردي، إنما هي حكاية مرتبطة بالتضييق القومي الذي عانوا منه عبر العصور، فإذا عدنا للتاريخ القريب، لن يخلو عامٌ من استهداف شبان أكراد قبل الاحتفال بالنوروز من قبل السلطات التي يرزح تحت سطوتها الكورد، يحصل هذا كل عام في أجزاء كردستان الأربعة، واعتاد الكورد على الاستمرار في الاحتفال مهما بلغ بهم الحزن على شهدائهم.
قصة شهداء جنديرس تختلف هذه المرة كونها حدثت خارج السلطة الحكومية كالمعتاد، إنما كانت اندفاعاً شعبوياً قائماً على وعي إسلامي يخاف النار، لأنها ترتبط لديه بالمجوسية، والمجوسية كفرٌ في نظر المسلم المتطرف، وإلباس هذا الخوف الديني من النار لحادثة النوروز، يضع الكردي المسلم أمام إشارات استفهام عدة تجلت في تساؤلات أهالي الضحايا كما ظهر في كل اللقاءات: لماذا؟
النار رمزاً للآخر المجهول.
في العصور البعيدة كانت النار رمزاً للتطهر الروحي، فهي ممثل النور الذي يمحي عنك الهمّ، وينمي زرعك وضرعك، ويهدي بصرك وبصيرتك, انتقل مفهوم النار من مصدر للتعبير عن الفرح بالنور، وهي الشمس في الاعتدال الربيعي، إلى مفهوم مظلم لعبادة عنصر من عناصر الطبيعة كما يفترضه عقل المسلم المتطرف، ليضع هذا الشخص في مأزق الخوف من نار لم يفهمها جيداً.
هذه النار التي كانت دليلاً للمجوس الأوائل في إنجيل متّى إلى مغارة الطفل يسوع بعد تتبعهم نجمَه من المشرق. تحولت في الإسلام إلى رمز للكفر والإشراك بالله، ولدى تتبع النص القرآني لن نجد شيئاً يبيح قتل مَن يشعل النار في احتفال ما. كذلك هو الحال في الأحاديث.
بل أنّ في الإسلام ذاته استطالة للرموز من عهد الجاهلية، والطواف حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود خير مثال على تفريق الإسلام بين الامتلاء بعبادة الإله دوناً عن رموز العبادة. فالنبي لم يلغِ أياً من شعائر الحج والطواف حول الكعبة سوى التصفيق والتصفير، أمّا ماء زمزم فهو عنصر آخر مقدس من عناصر الأرض، لم نزل نحتفي به لدى وصول كل حاج.
لم يحدث أن حظرت الاحتفالات بتقويم مختلف، واعتاد الخلفاء الأمويون على إرسال الهدايا في النوروز إلى الفرس، وكانت الاحتفالات تجري أمام قصورهم دون أية غضاضة. أما الاحتفال بالسنة الميلادية بل واستخدامها في كلّ الدول الإسلامية، فهو شاهدٌ آخر على التسامح مع الآخر بل والتعايش معه بقوانينه هو أحياناً.
المجوسية والإسلام.
يعرّف الباحث د.خليل عبد الرحمن في مقدمته للأفستا المجوس قائلاً: "مفرده مجوسي ، مصطلح من ميديا القديمة، وأصله "ماگو" ويعني الكاهن أو رجل الدين. وكلمة المجوس في اليونانية (Magos) أطلقها اليونانيون على كهنة زردشت بمعنى العظيم أو الهائل. وعندما صارت الزردشتية ديانة شعبية تولى المجوس مهمة تعليمها للناس، وعملوا على نشرها. وبما أنَّ النار كانت أكثر العناصر تقديساً في الزردشتية، لأنها تجسيدٌ رمزي للإله فقد قام هؤلاء المجوس بخدمة معابد النار، لذا لقب الزردشتيون خطأ بالمجوس، أي عَبَدة النار."
وكلمة "خطأً" هنا استمرت منذ عصور طويلة حتى اليوم لتسوق إلى حادثة جنديرس، دون أدنى رغبةٍ في تعديل هذه النظرة الضيقة، مع أن النصوص الإسلامية ذاتها، والتاريخ الإسلامي يشيران بطريقة مختلفة إلى أصحاب الديانة الزردشتية. وإلى احتفالات النوروز بوصفها أمراً منفصلاً عن التدين. فالنوروز هو رأس السنة الآرية الذي تحتفل به الشعوب الآرية فضلاً عن شعوب أخرى في المنطقة، وربط نار النوروز بالمجوسية خطأ شائع شديد الخطورة.
أول اتصال بين الإسلام والدين الزردشتي كان سلمان الفارسي الذي كان من صحابة النبي، قال عنه النبي: هو من أهل البيت، وهي مرتبة ندر من وصل إليها من الصحابة. كان سلمان واسمه الحقيقي روزبه ابن كاهن زردشتي، ترك أهله بحثاً عن معرفة الله، فانتقل من موطنه إلى نصيبين ليتعلم المسيحية، وعندما سمع بظهور نبي بين العرب، أتى مسرعاً ليلتقي النبي ويصير من أقرب المقربين إليه.
ويقول عبد الرحمن فضلاً عن الكثر من الباحثين، أنّ فكرة الجنة والنار انتقلت إلى أدبيات الإسلام عبر سلمان، وكلمة الفردوس لا شكّ فارسية الأصل، وكذلك جهنم ذات الأصل الميدي وفق تحليل الباحث أعلاه. ومن أكبر الدلالات على مكانة سلمان إسلامياً هو أنّ علياً رضي الله عنه قام بنفسه بتجهيزه ودفنه.
فصل القرآن في الحكم على المجوس بوضوح في آية الحج:
{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} الحج17
هنا نجد أنهم يعاملون كما أهل الكتاب، وأن الحكم عليهم متروك لله في اليوم الآخر. وعن جابر بن عبد الله، قال: «نهينا عن صيد كلبهم، وطائرهم، يعني المجوس». وتلك إشارة سلم لا غبار عليها تجاه أبناء هذه الدين.
تحركات الغوغاء برعاية الدول
يحفل تاريخ الامبراطورية الإسلامية بتقبل الآخر، بإيجاد حلول مثل الجزية، ولقد أخذ الرسول الجزية من مجوس هجر كما هو مذكور في التاريخ. أمّا التاريخ الحديث فينكفىء نحو القسر في دول شرعية تحمي هذا التطرف لأسباب سياسية بحتة. فالقتلة في جنديرس تحميهم السلطات التركية، التي تعتبر نفسها منارة الإسلام في الإقليم، بغض النظر عن أسبابها الخفية القائمة على البغض القومي.
بل قد تجد دساتير دولٍ تحفظ هذه الحقوق للغوغاء، وتعطيهم مساحة حكم على الآخر، والدستور الباكستاني خير مثالٍ على هذه الفوضى التشريعية. فقانون التجديف في باكستان يعتبر أساس التشدد الديني واضطهاد الأقليات في البلاد. اعتمد القانون خلال حكم الجنرال محمد ضياء الحق، كجزءٍ من قراره بالتعجيل بأسلمة الدولة. في العام 1982، نصّ القانونُ على السجن مدى الحياة لمن يقوم بتدنيس القرآن الكريم عمدًا، وفي العام 1986، تطورت عقوبة التجديف ضد النبي محمد إلى الموت، أو السجن مدى الحياة. ليستخدم القانون منذ ذلك الحين، ضد الأقليات الدينية دون أدنى خوف من العقاب.
أما عمليات التحويل الديني القسري في الدولة ذاتها فهي أمرٌ يحدث في نطاق الشرعية الكامل، والبيان المشترك الأخير لخبراء حقوقيين تابعين للأمم المتحدة، أشار إلى هذه الحوادث المتكررة لعمليات الخطف والزواج القسري ومن ثمّ التحويل الديني لفتيات من أقليات دينية في باكستان، ودعوا الحكومة على التحرك لوضع حد لهذه الممارسات.
فتياتٌ لا يتتجاوز أعمارهن الثالثة عشرة، يختطفن وينقلن لأماكن بعيدة للزواج من رجال ضعف أعمارهن لإجبارهن على اعتناق الإسلام. مهاجمة الأقليات بهذه الطريقة دليلٌ على عدم تقبل الآخر بأي شكل لدى المتطرفين الإسلاميين، أما أن يجري هذا بحماية دولٍ بعينها كما حدث في جنديرس فهذا مبلغ خطورة لا رجعة فيه.
إنّ إذكاء الخوف من الآخر برعاية دول تتخذ الإسلام ستاراً لتثبيت شرعيتها، لهو أخطر النماذج على مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بل لقد تطورت لتصبح خطراً اليوم على حياة مواطن برئ يسعى إلى الاحتفال بعيد موغلٍ في القدم، فيخسر حياته على ايدي غوغاء تستخدمها دولٌ متطرفة وتذكي جهلها بحقيقة الدين وحقائق التاريخ الإسلامي