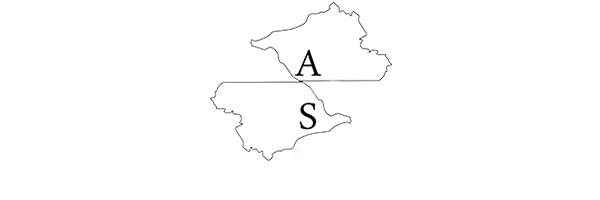البداوة السياسية عسكرٌ وطني عابرٌ للحدود
مور لوران
توجهت الأنظار مع بدء الحرب في السودان، إلى دراسة ظاهرة العسكر في العالم العربي والمشرق عامةً، بعد أن خفتت هذه الظاهرة إثر تغولها على المشهد السياسي في بداية التشكل القطري عموماً. لتبزغ في أعلى تجلياتها ثانيةً في الحرب السودانية. وتثير أسئلةً من نحو، ما مدى تنامي دور العسكر السياسي، وما العوامل التي قادت إليه، ولماذا توقفت الانقلابات عقوداً لتعود فتظهر اليوم على شكل حروب بينية بين العسكر . وهل نشهد فشلاً للدولة بمعناها البنيوي والقانوني، مقابل حكم بريتوري جديد فرضه ضعف تطور مفهوم الدولة في المجتمعات الشرقية؟
الدول ذات الحدود الاعتباطية
يتفق المفكرون على أن تشكل الدولة في الشرق الأوسط كان فكرة جاءت من الأعلى، أي أنها لم تنبثق من سيرورة داخلية للمجتمع، إنما كانت ثوباً سياسياً فضفاضاً ألبسه الغرب للمنطقة. إنّ حرمان هذه الدول من تطوير خبرتها الاجتماعية ذاتياً، لخلق دولة تشبه واقعها و ثقافتها، أدى بها إلى إنتاج دولة مشوهة، تشابه الغرب دون أن تطاله، وتجهد في تطبيق مفاهيم لا تنطبق كليةً على شعوبها.
لم تتخلص هذه الشعوب بعد من صدمة رسم الحدود اعتباطياً إثر منافسة استعمارية بين فرنسا وبريطانيا لتثمر دولاً قسّمت باستخدام مسطرة سايكس وبيكو. بقيت هذه الكيانات المبتدعَة تدور في فلك البحث عن هوية مشتركة لمكونات بشرية مختلفة بل ومتخالفة إثنياً ودينياً وطبقياً، ولعبت الحلول التي قامت بها السلطات الجديدة دوراً كبيراً فيما آلت إليه الأمور اليوم، بعد مرور ما ينوف عن مئة عام على التقسيمات الاستعمارية في الشرق الأوسط.
قبل الاستعمار الأوروبي استخدمت السلطات العثمانية التقليد الآسيوي في الحكم، على أساس الكيانات المتوازية، فالنظام الملّي القائم على احتفاظ كل كيان/ملّة بخصوصيته دون أيّ اندماج أو تكامل اجتماعي، استمرّ في الوعي المجتمعي لدول المشرق، ولم تسلم منه حتى دول الشرق الأدنى من قبيل باكستان بعد انفصالها عن الهند دوراناً حول الفكرة الملّية ذاتها. فالحكم العثماني لم يندمج كسلطة بحدّ ذاته في المجتمعات التي حكمها، ولم يسمح في الآن ذاته باندماج الكيانات المتوازية التي خلقها، ليسهل عليه حكم المنطقة واستجرار خيراتها دون بنائها تحت فكرة أمة حقيقية، حتى تحت مظلة الإسلام ظاهرياً.
بعد ظهور الدول القطرية المقسمة كما أسلفنا "اعتباطياً" بيد الاستعمار الأوروربي، بقيت حالة الكيانات كما هي في العمق دون الظاهر المعلن. أمّا السلطات المتعاقبة فقد استمرت في لعب دور الحاكم المنسِّق بين هذه الكيانات الاجتماعية، وتعطيل قوتها بخلق التنافس في ما بينها. أما السبيل الأنسب لفرض هذه السلطة فقد مرّ عبر تطوراتٍ كان أكثرها تجلياً حماية السلطة بالجيش.
قوى موازية دفعاً للانقلابات
قامت طلائع الجيوش على أسس وطنية بعيداً عن التدخل في مآلات السياسة، لتبدأ الحقبة الوطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى في كل دول المشرق العربي، لكن ونتيجة أسلوب السلطة القائم على تحييد الكيانات الشعبية، وخلق التنافس فيما بينها لضمان هذا التحييد، احتاجت السلطة إلى حماية مباشرة من الجيوش الوطنية، لتبدأ في تجهيزها بخطى حثيثة، حتى أصبحت الدول العربية الأعلى نصيباً في استيراد السلاح عالمياً.
إنّ هذا التوسع في حجم وكلفة المؤسسة العسكرية في معظم الدول المشرقية، قد عكس نفسه في تنامي الدور السياسي للعسكر ، لتبدأ بين الأربعينات والستينات حقبة الانقلابات العسكرية للاستيلاء على السلطة، ونتحدث هنا أقله عن ثلاث دزينات من الانقلابات في فترة عشرين سنة! لتأتي بعدها مرحلة السبعينيات التي توقفت فيها هذه الانقلابات لأسباب، يسعنا هنا التركيز على أحدها فقط، وهو مأسسة الجيش وخلق قوى موازية.
بعد تواتر فعل انقلاب الجيش والاستيلاء على السلطة، خاصة في دول مثل سوريا والعراق، بدأت السلطات في البحث عن تحقيق موازنة لقوة الجيش الوطني، لتطوق محاولات الانقلاب على السلطة، فخلقت كيانات مسلحة موازية، من قبيل الحرس الجمهوري وسرايا الدفاع، وفي حالتنا في السودان قوات الدعم السريع. لقد توالت هذه الطريقة حتى في دول كبرى عسكرياً مثل باكستان لينشأ الحرس الوطني والقوات شبه العسكرية. وهي النقطة الثانية التي سنتوقف عندها تباعاً.
حتى سقوط بغداد لم تشهد الجيوش الوطنية والقوى الموازية مواجهات جدية، حتى في الأزمة التي حصلت في سوريا بين الرئيس حافظ الأسد وأخيه رفعت، لم تتصادم القوتان. والسبب الأهم الذي يضاف إلى حكمة الرئيس حافظ الأسد في التعامل مع الملف، كان وحدة الأيديولوجيا والمنشأ نسبياً بين القوتين المتوازيتين، في شكل تغير اليوم نحو ظاهرة جديدة عالية الخطورة، تتمثل في تبني الأيديولوجيات العابرة للحدود.
العسكر العابر للحدود فكرياً
لم يكن سقوط بغداد كما بعده في العالم العربي خصوصاً والإسلامي عموماً، فالصدمة التي تلقاها الوعي الشعبي في انهيار الحلم القومي، جعله يبحث عن حلم آخر عابر للحدود، فالدولة القطرية لم تنجح في تطبيق أيّة سمة وطنية مشتركة لدى شعوبها، وبقيت دولٌ مثل سوريا والعراق ومصر حاملة لمشروع الوحدة العربية المجاوز للحدود، مهملة إلى حدّ ما، بناء مقومات الدولة القطرية الصغيرة، فبقيت تحلم حتى انهار الحلم القومي مرة بموت عبد الناصر، ومرة بسقوط بغداد.
بدأ البحث في بطون الكتب، ليظهر ابن خلدون والغزالي متحدثين عن صعوبة خضوع العرب لسلطان الدولة وسهولة خضوعهم لسلطان الدين. لتبدأ القوى الجديدة بالتفكير بالحل الإسلامي، وإدماجه بين فلول القومية المنهزمة، ليتفتق ذهن عزت الدوري الرجل الثاني بعد صدام حسين، عن دمج الفكر الإسلامي بالقومي، لتبدأ مرحلة تزاوج بين فلول البعث العراقي وطلائع القاعدة في العراق. ويستخدم البشير الفكرة ذاتها في السودان لدعم حكمه ذلك الحين، ويبدأ اقتران القومية بالدين رسمياً.
إن تغلغل هذه الأيديولوجيات العابرة للحدود بين صفوف الجيش والقوى العسكرية الموازية، تمظهر عدة مرات كان من بينها مقتل السادات، لكنه يأتي اليوم في أشد أشكاله عنفاً بالمواجهة المسلحة بين الجيش الوطني والقوى الموازية في السودان، ليفسر خطورة تبني الفكرة الأوسع على حساب الدول الوطنية الصغيرة. فما مستقبل الدول المنفصلة على أساس ديني؟
تفكك الدول على أساس ديني
شهد العالم حادثتين من هذا النوع، كانت أولاهما انفصال باكستان عن الهند في أقوى مشهد دراماتيكي سياسي في العالم، أما الثانية فكانت انفصال جنوب السودان. لم يسفر أيّ من الانفصالين عن بناء دولٍ بحالة مدنية صحية، إنما شهدت الدولتان سيطرة للجيش وإن من خلف ستار. بل وباتت تعاني من التطرف الفكري ضمن نسيج الدولة ذاتها، ليبدأ صراع آخر بين الأصوليين في حالة باكستان مع الجيش، وبين الإخوان مع الجيش في حالة السودان كما هو بادٍ اليوم للعيان.
لقد بقي الجيش في باكستان أقوى المؤسسات في البلاد، ممسكاً بمفاصل هامة في الدولة، بل وكثيراً ما أطاح بحكومات مدنية منتخبة ديمقراطياً على أساس اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، واستخدم الإسلام السياسي ذريعة للحكم، حتى تغلغل الفكر العابر للحدود بين أفراد الجيش، لتجد تحريك طالبان ثغرات سهلة تهاجم عبرها نقاط الضعف مراراً وتكراراً. باكستان اليوم تغرق في عمليات إرهابية متكررة تستهدف حتى المدنيين، فقبل يومين نفذ هجوم مسلح استهدف مدرسة في شمال غرب باكستان قتل فيه ثمانية أشخاص على الأقل.
أمّا انفصال السودان فنتائجه تتضح اليوم في فشل الدولة، وولاء كلّ من الفصيلين المتصارعين لقوى إقليمية تتجاوز الحدود الوطنية، وتطيح بآمال المدنيين في حياة كريمة بعد الانتفاضة على البشير. في كلا النموذجين لم نحصل على دول مستقرة حتى بعد التوحد خلف أيديولوجيا واحدة، وذلك لأن التطرف في هذا الفكر في حالة باكستان قاد إلى حروب بينية تبشر بالمزيد من العنف في الأيام القادمة. ولأن المؤسسات العسكرية استمرت في التغول وفي استخدام الحكم الإسلامي ذريعة لاستمرار سيطرتها على السلطة في الخفاء، بدأت البريتورية الجديدة تظهر، بتقاطع البيروقراطية مع تدخل الجيوش في حكم الدول، ولكن هذه المرة بفكر عابر للحدود الوطنية. وهذا أقوى تجليات فشل الدول في قادم الأيام.
خاتمة
يتحدث غرامشي مطولاً عن البداوة السياسية التي كانت سبباً معطِّلاً للدولتية بشكلها الواضح في المشرق ليقول: " إنّ هذا ناجم عن مزيج من العوامل وهي:
- اللاهتمام التقليدي بالسياسة والسلبيّة لدى الجماهير الشعبيّة.
- ووجود بروليتاريا رثّة كبيرة وفئات دنيا أخرى متخلّعة طبقيّاً.
- ووجود بورجوازيّة متوسطة وصغيرة (من النمط الريفي) تقوم بإنتاج عدد كبير من <المثقفين المتذمرين> وهم بالتالي <متطوعون> لأيّ مشروع هدّام على نحو غامض ( حتى أكثر المشاريع غرابة) "
كلّ هذه الأسباب تواترت أمام أنظارنا بعد الربيع العربي، وتضع إحدى التفاسير المحتملة لاستمرار سيطرة الجيوش في المجتمعات المشرقية، أمام انزلاق هذه الدول نحو الفشل، وضياع الخط الوطني في حماية شعوبها ضمن الحدود الوطنية. وعدم قدرة الكوادر الثورية على التخلص من هذه البداوة، صاغ انهياراً للمشروع التغييري الذي قام على عجل، وانتهى بكوارث في المنطقة، قد تغير وجه المكان، إلى فوضى غير محتملة.