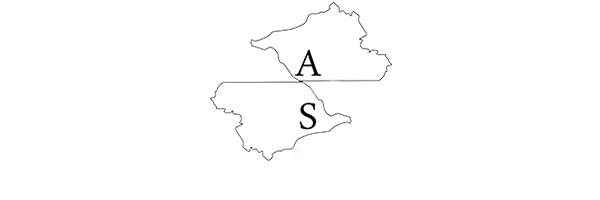الديمقراطية مدخلاً إلى الثيوقراطية
مور لوران
ما من مفهوم يفوق الديمقراطية، في تمثيله الدولة الحديثة، بوصفه البصمة النهائية، لممارسة الفرد حقوقه، مواطناً كامل الأهلية ضمن دولة القانون. وهو الشكل الناجز للدولة الذي فرضه الغرب بعد الحرب العالمية الأولى على العالم، ليحلّ مكان الإمبراطوريات السماوية بحكمها الثيوقراطي، وطبيعتها السلالية. ويبدأ صوغ شكل جديد هو الدولة القومية، دولةً بحدود ودستور واضحين.
بدأ شكل الدولة القومية في الشرق، يهتزّ في العقد الأخير، بعد نجاح قوى مؤدلجة دينياً، في الوصول إلى السلطة، عبر أدوات النهضة الأوربية ذاتها، وهو صندوق الانتخابات. ما يثير تساؤلات حول مدى نضج فكرة المواطنة، بل ومواءمتها للمجتمع المثالي المتخيّل. فنجاح الفكر السياسي الإسلامي في انتخابات تركيا اليوم، ينتج ظاهرة من أشدّ مظاهر الديمقراطية غرابة، وهو ثيوقراطية الحكم في دولة حديثة. وهذه المرة دون وجود حكم عسكريّ في الخلفية كما هو الحال في تجربة باكستان.
فما الذي قاد هذا البلد الرائد في العلمانية، إلى النزوع الديني مجدداً في اختيار قادته؟ وهل القومية عاملٌ مساعدٌ أم متحوّل أمام هذا الاستحقاق الجديد؟ وما مستقبل دولة دينية جديدة في الشرق، بعد إخفاقات إيران وباكستان في إقامة حكم الشريعة تحت سقف الدولة الحديثة؟
دولة الحداثة والحدود
لم تكن الدولة الحديثة في أوربا، سوى نتاجٍ لتراجع اليقينيات الدينية بعد اكتشاف العوالم الجديدة، وبزوغ عصر العلم والتكنولوجيا. لتظهر مفاهيم جديدة مثل حدود الدولة: من الصعب على الفرد الحداثي، تخيّل إمبراطوريات ومَلَكيات قديمة، عاشت بحدود متخيلة أكثر منها مرسومة. فعلى سويّة الخرائط _وهي أداة حديثة_ لا نجد رسماً حقيقياً يوافق إمبراطورية روما، بل لعل القيصر ذاته لم يمتلك فكرة كاملة عن حدود إمبراطوريته. تلك الحدود المتغيرة كانت تدار من مركز واحد، يستمدّ شرعيته من السماء. وكان يبسط نفوذه على رعايا، تحدّد الشرائع الدينية علاقته الغيبية بهم، دون حاجة حقيقية إلى تواشج سياسيّ معين، بينه وبين الرعيّة.
لا حدود إذن للعالم المسيحي وفق التصوّر الروماني. كذا كان الحال في تخيّل حدود العالم الإسلامي في عهد الخلافتين العربية والعثمانية، فالدين اعتناق، وأيّ فرد يعتنق الإسلام، منتمٍ بالضرورة إلى الأمّة الإسلامية. بقيت هذه الفكرة في المخيال الإسلامي، دون أن تتمكن سياسات الدولة الحديثة من تحييدها على ما يبدو.
لقد قامت الدولة عبر النظام التربوي المجاني والإعلام والنظام الإداري، بفرض قيمها الجديدة، ضمن حدود مرسومة واضحة، في كلّ الدول التي تلقّت الحداثة وهيمنتها العالمية في الشرق، لتخلق شرخاً في المخيال الدينيّ، القائم على اللاحدود بطبيعته. وأهم أسباب استمرار هذا الشرخ في الوعي الإسلامي التركي بالذات، هو طريقة تطبيق أو فرض هذه القيم، على وريثة الخلافة الإسلامية، بأسلوب واحد هو: القسر.
العلمانية وذاكرة القسر
لا خلاف حول اعتبار الدولة التركية الحديثة، وليدة قسرٍ قامت به الأفكار العلمانية، عبر أداةٍ عسكرية شديدة الصرامة، تمثّلت في شخص مصطفى كمال.لتتحوّل الأفكار اللائكية الفرنسية التي مرّت عبر مفكرين كبار، من أمثال عبد الله جودت، إلى نوعٍ من القسر غير الملائم لطبيعة الفكرة ذاتها، بعد تبنّي العسكر لها.
هبطت العلمانية على تركيا، عبر عمليات صارمة بل وإقصائية بحتة، فقد اختار مصطفى كمال _وهو من أكابر المعجبين بالمفكر والطبيب الكردي عبد الله جودت_ طريقة الصدمة في تطبّيق كلّ أفكاره على أرض الواقع، (عدا قضية الإنتماء الكردي)، خلافاً لمحاولات العثمانيين التوفيقية بين المؤسسات الشرعية، والمؤسسات الحديثة المستوردة من الغرب. لقد دفعته الطبيعة المهيمنة للحداثة، بوصفها حدثاً عالمياً، إلى محاولة اندماج سريعة، قادت إلى كثير من الأخطاء التي نقطف غراسها اليوم.
تحولت العلمانية في تركيا من مفهوم يحترم جميع الأديان، إلى مفهوم معادٍ للإسلام، أقلّه في الشكل والرموز، فأيّ متدينٍ سوف ينسى قانون السفور، في الثاني من أيار 1925، عندما أجبرت النساء على خلع الحجاب قسراً. وأيّ كرديّ سوف ينسى عملية التتريك التي طالت حتى الأسماء الشخصية، أو ينسى ثورة الشيخ سعيد، ضد هذا التتريك، والقمع غير المسبوق الذي مارسته الدولة القومية التركية الحديثة لهذه الثورة. كان القسر المَعلم الأكبر للعلمانية المطبّقة في تركيا، ولهذا القسر جذورٌ لا ريب في صعود المدّ الديني اليوم، ليطال صندوق الانتخابات نفسه. مستخدماً أداتين معاً، فكرة الدولة القومية القائمة، وفكرة الأمّة التي لا حدود لها وفق المخيال الإسلامي.
الوطن والأمة
"لا قدّر الله زوال الوطن ولا زوال الأمّة"، بهذا نطقت ابنة السلطان عبد الحميد الثاني، معانقةً والدتها في أول اجتماعٍ لهم، بعد إخراج الأسرة من تركيا عام 1924. لتسجّل لنا مقولة، من أشدّ المقولات تعبيراً عن الحالة في تركيا اليوم.
ما تعنيه عائشة بالوطن، هو الدولة التركية القومية بحدودها الناجزة بعد الحرب العالمية الأولى، والتي قام مصطفى كمال بلقبه أتاتورك (أبو الأتراك)، بتعميق خطوطها القومية،بفرض سياسة التتريك على جميع الشعوب التي تحيا ضمن حدود هذه الدولة الجديدة. والتي طالت حتى الأسماء الشخصية، بل وحتى إعادة تسمية شعبٍ بأكمله مثل الشعب الكردي، بأتراك الجبال. استمرّت هذه السياسة عقوداً عدّة، عبر التعليم والإعلام والبيروقراطية، لتنتج نوعاً من العنصرية التركية، بقيت الكابح الأكبر للديمقراطية الحقيقية في تركيا.
أمّا المفهوم الثاني في مقولة عائشة، فهو الأمّة. المفهوم شديد السطوع في معناه، أمّة الإسلام، الحلم غير المحدود بزمان أو مكان، والذي قادت رايته الأحزاب الإسلامية في تركيا بجدارة حقّة. داخل الحدود وخارجها، فكيف لنا أن نتجاهل صرخات الاستحسان المتواقتة في مسجد آيا صوفيا، والمسجد الأقصى، جميعاً ومعاً في لحظة فرح واحدة بنتيجة الانتخابات؟ لم يكن الفوز لحزبٍ وفق المخيال الشعبي، إنما كان فوزاً لحلم الأمّة الإسلامية، الأوسع.
كان لتواشج هذين المفهومين، الأثر الأكبر في الفوز بالانتخابات التركية، فعلى حين تمسكت الأحزاب القومية، بخطابها المترهل لعلمانيةٍ أثبتت فشلها، بعد ردِّ الفعل الديني الواسع في تركيا اليوم. طوّرت الأحزاب الدينية فكرةً قائمة على الجمع بين القوميّ والدينيّ، بل وطالت حتى العنصريّ، الزرعَ الأسود لقسر الدولة التركية السابق، لتسوق العدد الأكبر من الناخبين إلى جانبها في صندوق الاقتراع.
تناقضات الديمقراطية التركية
في دلالة واضحة، أعاق قسر الدولة التركية عبر التاريخ قيام مواطَنة حقيقية، تسهم في دفع عجلة الديمقراطية الحقّة في الوعي الشعبي. لقد ولّدت عمليات التتريك نضالاً قومياً موازياً للشعوب المقموعة، كما كان الحال في حركة حزب العمال الكردستاني. الذي استطاع تطوير ذاته في شكل ديمقراطي شامل، ليظهر جناحه السياسي ممثلاً في حزب الشعوب الديمقراطي، على عكس بقاء الحركة القومية السلطوية في تركيا على تحجرها العنصري. وقمعها المستمرّ للحركة السياسية الكردية.
لهذا القمع أثره الواسع على العملية الديمقراطية في دولة مثل تركيا، يبطئ تطورها الذاتي الطبيعي، ويدفع الوعي الفردي للبحث عن تقيّة، فإذا كانت الشراكة السياسية للشعوب المختلفة قومياً ممنوعة، لماذا لا نبحث عن مسارب أخرى، للوصول إلى هذه الشراكة؟ من هنا ابتدأ انضواء بعض الحركات الكردية تحت مظلة الأحزاب الإسلامية التركية، التفافاً على الملاحقة المستمرة، وبحثاً عن الحلم الأوسع، أمّة الإسلام، حيث الميثاق الملّي، الذي أعطى الكورد حقوقهم في حكم ذاتي مكتمل، كما فعلت الإمبراطوريات الإسلامية قبلهم.
من هنا تبدو الديمقراطية التركية التفافاً على القمع بأسماء مختلفة، أكثر منها تعبيراً عن رأي مواطنٍ حرٍّ في التعبير عن قناعاته، وفي اختيار مرشحه الأنسب. لم تتطور الحداثة في العقل التركي نتيجة تطبيقها عنوةً بأسلوب الصدمة، ليبقى حلم الإمبراطورية في تلافيف الوعي الشعبي. فاستمرار العنف القومي لم يسمح للديمقراطية التركية بتطوير ذاتها لتبقى في صورة صندوق استفتاء عادي، يجمع الأصوات دون القناعات، ويخلق دولةً ثيوقراطية في مستقبلٍ يحمل من التناقضات أكثر مما يحمل من آمال.
دولتان إسلاميتان في قالب الحداثة
قد نقرأ خطوط البخت في فنجان تركيا، إذا استعدنا تجربتين لدولتين إسلاميتين قائمتين. أولاهما باكستان التي انفصلت عن الهند على أساس دينيّ، وثانيهما إيران بعد ثورة الخميني. لم يأخذنا إلباس الإسلام لقالب الدولة الحديثة، سوى إلى تناقضات لا تني تتزايد على مرّ قيام هاتين الدولتين. من أهمها ما أسلفنا ذكره في وسم الحدود. فالدولة الحداثية ذات حدود جغرافية واضحة، تتناقض بدّاً مع مفهوم "الأمّة" في الفكر السياسي الإسلامي. والقائم أصولاً على مبدأ التبشير، والتوسع دفاعاً عن العقيدة، كما فعل الإسلام في كلّ مراحل حكمه الإمبراطوري للمنطقة.
في مثال باكستان، نجد تمسكاً ممنهجاً بمواصفات الدولة الحديثة، للتعامل مع النظام الدوليّ وفق شرعية قانونية. لكنها لا تتخلى في الآن ذاته عن حلم الأمّة، حيث لا حدود توقف التبشير بالعقيدة، وتورطها الدائم في أفغانستان، وبل ودعمها المستمر لحركات جهادية بعينها، خير شاهدٍ على هذا التناقض الحيّ. والذي يسوق إليها اليوم تحريك طالبان باكستان، شبحاً يحارب الدولة، لترتدَّ الأفكار إلى عمق الدار الباكستانية، دون وجود حلّ للتناقض بين مفهوم الدولة القومية والأمّة.
لا ريب أنّ جهود التوسع لدى كلتا الدولتين، متشابه من حيث الشكل والنتيجة، فالتورط المستمر في النزاعات الإقليمية، وضخّ القوات المحترفة جهادياً، وعقائدياً، أساء أيّما إساءة إلى الوضع الاقتصادي للدولة، لتقف باكستان اليوم على حافة الإفلاس، بعد أن قفزت ديونها بنسبة 34% في عام واحد، لتتجاوز 205 مليارات دولار. أمّا إيران وبعد عقود من العقوبات، تكاد ترى أشباحاً لا مواطنين سائرين في شوارعها، دون أيّ تغيّر لأدوات قمع الدولة.
يسرد المفكر وائل حلاق في كتابه "الدولة المستحيلة" أسباباً عدّة تبيّن استحالة تحقق مفهوم "الدولة الإسلامية" لإنطوائه على تناقض داخلي، وفق أيّ تعريف سائد لمفهوم "الدولة الحديثة". ويسهب في شرح مأزق الحداثة الأخلاقيّ، ليضعنا أمام الملعب الحقيقي للإسلام السياسي، في تغذية الحلم الأخلاقيّ لدى الجماهير التي حرمت منه بعد تغوّل العولمة والسوق، والبحث عن سعة لحلم قديم، كان فيه من الحرية أكثر مما قدمه قسر الدولة الحديثة.