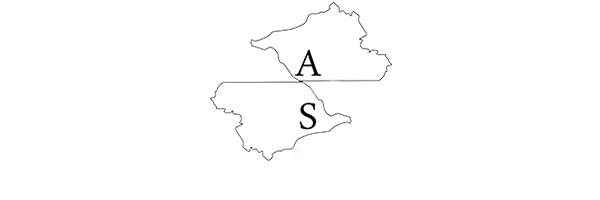الشعبوية وحاضر الاستبداد
جوانا محمود
على حين تتعامل الدول الديمقراطية مع الشعبوية بوصفها مناوئاً خطيراً للفعل الديمقراطي داخل الدولة، نجد أن الدول المستبدة أو حديثة العهد بالممارسة الديمقراطية، تستخدم تلك الظاهرة لتنفيذ أجندات سياسية نخبوية معينة. مغامرةً بتحويلها إلى فعل مؤدلج، لا حدود لخطورة ما سوف ينتجه في قادم الأيام.
ليست الشعبوية سوى اعتلالٍ يعتري جوهر الواقع الديمقراطي، فيدفعه إلى تعديل بنيته، بل ومراجعة النظام الليبرالي برمته، وهذا ما يدأب عليه المفكرون في الغرب اليوم. قبل أن تتحول إلى عملية فعلٍ ورد فعل، كما حصل في حدثين مؤخراً، أولهما احتجاجات فرنسا. وثانيهما تظاهر مدن باكستانية بعد حادثة حرق نسخة من المصحف في السويد.
على خلاف ما تسعى إليه دول الاستبداد، التي تربط آلة الدعاية السياسية بالظاهرة الشعبوية، لتسهيل فتح قنوات التأثير عن بعد، في بثّ الدعاية عبر أدوات العالم الليبرالي نفسه، من إنترنت ووسائل تواصل اجتماعي. تساعدها في تدعيم هذه الظاهرة الخطيرة، طبيعتها الاستبدادية، وسهولة ضرب المثل الديمقراطية في عرض الحائط. وما صورة أردوغان المتداولة في باكستان سوى مثال صارخ لهذه العملية.
إرهاصات الشعبوية
ظهرت العولمة كأحد أعراض الليبرالية الجديدة، ومنذ التسعينيات شهد العالم ردود فعل مناهضة للعولمة، ليرتبط الصعود الشعبوي بسؤال الهوية.
مع انهيار الاتحاد السوفييتي، تشكل المتحور النيوليبرالي المشتق من ليبرالية السوق، ليبدأ التبشير بالوصفات السياساتية المعروفة على مستوى العالم، من إلغاء للقيود وخصخصة وحرية تدفق رأس المال، مستهدفة ملأ الفراغ المتأتي من غياب الشيوعية، سيما في الشرق الأوسط.
تزايدت إخفاقات الليبرالية مثل تآكل الحماية الاجتماعية وزيادة عدم المساواة، وفرض مبادئ السوق على جميع مجالات الحياة البشرية، وزال بريق الليبرالية بعد أن سادها التلفيق والتزوير، بتزايد الفساد السياسي، لتفقد ثقة الشعب الذي تنامى سخطه على النخبة والأحزاب، فبدأ البحث عن قادة جدد، يضعون رغبات الشعب فوق كل مطلب.
لقد أصبح المدّ الشعبوي المخرج المثالي للسخط الجماهيري المتصاعد. وتحول إلى أسلوب تمرّد للقطاعات الجماهيرية المتضررة من سياسات الليبرالية الجديدة، والتطور الصناعي في الغرب، خاصة في الدول المغتربة عن ثقافتها الجديدة، بعد التنوع الاجتماعي والديموغرافي الذي فرضه تغير البنية السكانية بعد الهجرة.
أما احتجاجات فرنسا فلا تنفصل عن هذا السياق، فالقلق العميق من التعددية الثقافية، والإخفاق في مواجهة تحديثات الهجرة واللاجئين، وتعقيدات العولمة، سارت بالسخط الجماهيري إلى أوجه، ليتبنى الشعبوية بديلاً مساهماً في فقدان إيمانه بالدولة.
ولأن كل فعل يستوجب ردّ فعل، سارت الفئات غير المندمجة كلياً في الدولة العلمانية، نحو التقوقع حول ثقافتها الأم قبل الهجرة، يساعد في هذا آليات العولمة التي أزالت الحدود أصلاً، لضمان إعادة إنتاج رأس المال على المستوى العالمي، دون حساب تدفق ثقافات رجعية، قد تكون نصلاً معاكساً يوجه إلى قلب المجتمع الديمقراطي بذاته.
هذا التدفق ترعاه بلا ريب دول استبدادية على الجانب الآخر، لا تجد غضاضة في تجاوز قيم الديمقراطية، وباستخدام قادةٍ مثل أردوغان أو حكام باكستان الذين ساهموا في تأجيج الشارع بعد حادثة حرق المصحف في السويد.
الليبرالية ورطة الشرق
يمر العالم بكليته بمخاضٍ يرسمه اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، فالدخل الحقيقي للعاملين لم يرتفع منذ العام 1980 رغم أن الاقتصاد الصناعي ينمو باضطراد. أما معاناة الشرق فهي معاناة مضاعفة، فقد تفاقمت الضغوط بعد انهيار الاتحاد السوفييتي باتجاه التحرر الاقتصادي الذي اخترق كافة التكوينات القطرية، تحت تأثير مطامح التحول الديمقراطي العالمي، لترزح دول الشرق السلطوية تحت عبء زوال السياسات الحمائية بدءاً من الثمانينيات، كجزء من الاتفاقيات التي ربطتها بالولايات المتحدة وباقي العالم الحر.
بعد الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول في الشرق الأوسط في السبعينيات، بدأت هذه البلدان تعتمد على واردات الغلال بدل إنتاجها ذاتياً، وتوقف الاعتماد على المزارعين في إنتاج الغذاء، لتنحسر نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 23 في المئة في كلّ من مصر والمغرب والجزائر، بل وتسارعت الاستدانة بعد "صدمة فولكير" عندما رفعت الحكومة الأمريكية أسعار الفائدة ارتفاعاً مهولاً في العام 1979، لتواجه هذه الدول صدمة تحصيل العملة الصعبة، وتدفع كل من الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس 65 بالمئة من أرباح الصادرات لتسديد ديونها.
لقد استخدم الغرب كلّ طاقته في ربط باقي دول العالم بآلة الليبرالية، وعبر آليات الديون والمساعدات، ليسوق بعض الدول التي تعاني من عدم الكفاءة الاقتصادية نحو أزمات أعمق. هذه الأزمات وثيقة الصلة بكافة الأزمات الدولية التي يعاني منها الغرب اليوم. فالبطالة الكبيرة والديون التي عانت منها دول الشرق بعد الأزمة المالية العالمية في الثمانينيات وتراكبها مع صدمة فولكير، وخوف الأنظمة السلطوية من تزايد انتشار الفكر الليبرالي، أنتج المزيد من الأزمات وآليات سلطوية جديدة للتعامل مع النظام العالمي.
استحكام النيوليبرالية والدفع المعاكس
ما بعد هجمات 11 أيلول اختلف عما قبلها، فقد شهد المجتمع الدولي ممارسات مستحدثة، لا علاقة لها بقيم الليبرالية، بدأت بإعلان جورج دبليو بوش الحرب على الإرهاب. ولم تنتهي بالثورات الملونة في دول ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بل وتبعها الربيع العربي، ليشهد العالم خطورة النظام الليبرالي، وأدواته من منظمات غير حكومية، ومفاهيم المجتمع المدني، ووسائل التواصل الاجتماعي التي تخترق القيم المحلية، وتعاند في نشر قيمها الخاصة وفرضها على المجتمعات الأخرى. لتظهر هنا سويتان للمقاومة، أولاهما على مستوى السلطة، وثانيهما على مستوى الجماهير.
بعد الخطر الذي التمسته الأنظمة الاستبدادية من الاجتياح الغربي الليبرالي، بدأت السلطات في تحصين نفسها من التهديدات العابرة للحدود. ولأن هذه الأنظمة غير ديمقراطية في طبيعتها، فمن السهولة بمكان مخالفة كل الإجراءات الديمقراطية، بل وباستخدام أدوات الليبرالية ذاتها من وسائل تواصل اجتماعي، لخلق بيئة موافقة للنخبة السياسية. وبدأ هنا اختراق الوعي الشعبي. بل واختراق الحدود الإقليمية لمجابهة الخصوم، وتغيير بنية المجتمعات الموازية، بخلق شعبوية سيبرانية تؤثر فيما هو أبعد، نحو المجتمعات الغربية، حيث يقبع المهاجرون الجدد، الذين ما زالوا محتفظين بقيم الأوطان التي هاجروا منها، بسبب سياسات الغرب في بلادهم.
يمكن للدول الاستبدادية أن تحدّ من تأثير المجتمع المدني الدولي ، ومؤثرات السوق، بل والإنترنت على مجتمعاتها بفعالية أكبر مما تفعله الديمقراطيات الغربية، بل أنهم يؤثرون في المجتمعات الغربية بتشكيل ملفاتهم ورفع مكانتهم لدى الجماهير العالمية، وما صورة بوتين المنتشرة راكباً ظهر الدب الروسي بمعزل عن هذه الممارسات. يدل على سبل سهلة لاختراق الوعي الغربي بالمقابل.
لقد خلقت حرب العراق وحرب أفغانستان، والثورات الملونة والربيع العربي، المزيد من الساخطين المهاجرين في قلب المجتمع الغربي، ولم تتمكن النيوليبرالية من تحوير نفسها وما يتفق مع البنى الاجتماعية الجديدة بعد تدفق المهاجرين إليها، بل أنتجت المزيد من السخط والتطرف، ليضع النظام الديمقراطي اليوم أمام خطر المواجهة بين فصيلين، الشعبويين الجدد مع أزمة الهوية المتجدد داخلهم، والمهاجرين الجدد الذي أخفق المجتمع في دمجهم مع القيم العلمانية.
على حين تكابد دول القانون تحولاتٍ ضمن بنيتها الليبرالية ذاتها، لتسهيل احتواء ظاهرة الشعبوية، دون المساس بمثل ودساتير الدولة. يغيب عن بصر هذه الدول أن المستبدين على الضفة الأخرى، يدفعون بشعبوية جديدة، تترعرع ضمن قيم أيديولوجية، لتواجه خطر أدلجة الشعبوية عالمياً وتصيب البنى الاجتماعية في العالم في مقتل. وحادثة حرق المصحف وباكستان أكبر مثال على هذا.
شعبوية السلطة
لقد تمكنت الديمقراطية الغربية من احتواء ظاهرة الشعبوية حتى اليوم، وما انتهاء تمرد فرنسا سوى دليل حيّ على هذا، وحتى عندما وصلت الشعبوية إلى رأس السلطة كما الحال مع ترامب، تمكنت الديمقراطية من النفوذ عبر العيوب الكبيرة التي ساقتها إلى هذه التجربة. وباستخدام القانون ذاته دون اي التفاف أو تغيير. أما في الشرق فوصول الشعبوية إلى قمة السلطة يسوق المجتمعات إلى أقصى حدود الخطورة.
في أواخر حزيران الماضي أحرق مقيم بالسويد من أصول عراقية نسخة من المصحف أمام مسجد في استوكهولم بعد سماح السلطات السويدية له بهذا. لتخرج 200 تظاهرة في باكستان مطالبين بطرد السفير السويدي، وبشعارات أقلها الموت للسويد. قد يمرّ هذا كاحتجاج عادي مالم يحصل بحضّ مباشر من رأس السلطة في باكستان.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد دعا في تغريدة له، إلى احتجاجات في أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة، وحض على تخصيص اليوم للدفاع عن "قدسية القرآن". قائلاً على تويتر: "من أجل التعبير عن مشاعرنا وعواطفنا بشأن تدنيس القرآن الكريم، بأيدي شخص ملعون، سنحتج بمختلف أنحاء البلاد اليوم، تحت عنوان يوم القرآن الكريم"
هذا ما يسمى بشعبوية السلطة، التي تتبع الشارع بل وتدفع به نحو أدلجة شعبويته، وهذه المرة دينياً، لتثبيت التوافق بين الحكومة والشعبوية العامة، وترسيخ الحكم الذي يعاني أصلاً من اضطرابات مستمرة سببتها الديون المتراكمة نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة، وتورط في حروب جهادية في أفغانستان على مرّ عقود.
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪول اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﺳﺘﻐﻼل ﺗﺒﻮء ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺮﻳﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻬﺎ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة. إن ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ورﻏﺒﺔ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻛﺒﺮ. وإخفاق النيوليبرالية في تحقيق الرفاه في الشرق، قاد إلى شكل جديد من الشعبوية هو الشعبوية المؤدلجة، بكل ما تحمله من معاني العاطفية والتوق إلى الأخلاقي بطرق غير واعية بحركة التاريخ.
هذا الشكل هو ما سوف تعاني منه المجتمعات الجديدة في الشرق والغرب، وتؤول ريادة صناعته إلى الاستبداد.