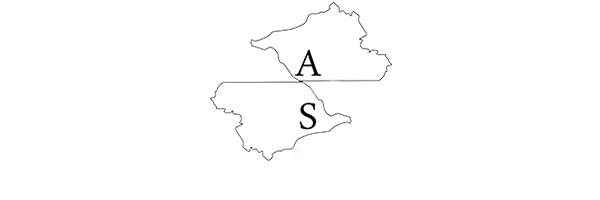تعدد الأقطاب عالم عدم اليقين
جوانا محمود
بقدر ما يتطلع العالم إلى أيّ تغيير محتمل على سياسة القطب الواحد، بقدر ما يغضّ البصر عن عواقب هذا التغير في حال حدوثه. بل ويرفض العقل التفكير في الشكل المحتمل لهذه الأقطاب، ونسبة استدامتها، والوضع العالمي في حال نفي هذه الاستدامة.
عندما بدأ دونالد ترامب بتطبيق مقولة "أميركا أولاً" في عالم السياسة الفعلي، تبدلّت ملامح النفوذ الجيوسياسي في مختلف مناطق العالم، والشرق الأوسط بخاصة. فهذه المقولة التي خُلقت ولا ريب من رحم إرهاصات ثورة بيضاء في الداخل الأمريكي، كان لها التبلور في شكل سياسي واضح تمثل في قيادة الولايات المتحدة. والسؤال الذي أنبت هذه الثورة الهادئة شكلاً، العميقة مضموناً كان: لماذا تتحمل الولايات المتحدة تكاليف قيادة الأمن العالمي؟
لذلك وعلى خلاف ما يُعتقد، فإن الانسحاب الأمريكي التدريجي من العالم، كان نتيجة وعي تاريخي بدأ بالتبلور تدريجاً في العقل الأمريكي، وما مقاومة الدولة العميقة له سوى نوعاً من إعادة ترتيب الأوراق، لضخ منافع الفراغ الناتج في المصلحة الأمريكية قبل الانسحاب الفيزيائي من مناطق مثل الشرق الأوسط وأفغانستان.
من السذاجة الحديث عن ضعف أمريكي في ظلِّ وضوح أثر العقوبات الأمريكية على عميم الدول، لكن من التطرف في السذاجة أيضاً الحديث عن أمريكا مهيمنة كلياً على العالم كما حدث في الربع قرن الماضي، فأمريكا ذاتها بحاجة إلى قطب آخر يزيح عنها الهمّ العالمي المتراكم. والمشهد العالمي اليوم يتيح أكثر من سيناريو مرضٍ للعقل الأمريكي.
عديد الأقطاب المرشح اليوم، يتراوح بين قوى كبرى إنما غير متكافئة ولا متفقة المصالح دوماً، فالصين وروسيا لم تتحدا حتى في أزمنة اشتركتا فيها أيديولوجياً في فكر شمولي راسخ سيطرا به على ربع سكان الكرة الأرضية! أمّا أوربا فكان لها نصيب الفشل الذريع في جسم الاتحاد الأوربي وتعثره حتى على سوية التوحد الاقتصادي. أما القوى الجديدة مثل الهند والبرازيل واليابان فهي أذكى من أن تدخل في حمائيات دائمة فتركيزها الأولي هو الإنماء الذاتي، وطرح التحالفات المتبدلة وفق ما يسوق هذه المصالح.
قطب المستقبل المقابل لأمريكا والحال هذه، قطبٌ يعتمد على شكل هيولي، رابطةٌ من التحالفات المرنة بين كل هذه القوى بأشكال متعددة. يوازن في شكله الكلي والجامع ثقل أمريكا، لكنه لا يوازيها قوة ومتانة، فتبدل التحالفات بين هذه الدول أمرٌ واقع، واعتماد فكر السوق لصنع هذه التحالفات يخلو من موضوع أساسي وهو: الأيديولوجيا. فما المشروع الفكري الذي تحمله الصين في خطها الحريري المرتقب؟
لطالما عجزت الصين عن فهم العالم فكرياً، ناهيك عن التأثير فيه، أما أمريكا فلا زالت تحمل الديمقراطية فكرة تسيطر على العقول الجديدة، واستطاعت عبر التاريخ غسل عقول البشرية بها، وخنق أي فكر معارضٍ لها، فمن منا اليوم يتجرأ على انتقاد الديمقراطية دون أن يكفّر كما فعلت الأديان سابقاً؟ وأيّ مفكرٍ تمكن من وضع فكرة أقوى وأشد لمعاناً من الديمقراطية حتى اليوم؟
إن عجز أي قطب من هذه الأقطاب الجديدة عن صنع فكر موازٍ لعمل السوق، نقطة ضعف فاعلة سوف تؤثر مستقبلاً على مدى ترابط هذه الأقطاب، بل وعلى صراع محتمل بينها. ما يجمع هذه الأقطاب هو المنفعة الاقتصادية، ونزوع روسيا ومن بعدها الصين نحو أفريقيا، لا يحمل في طياته سوى استنزاف اقتصادي جديد للقارة مهما حملت الصين من شعارات هشة للسلام.
إنّ مصطلح "التحديث السلمي" الذي تبدأ به الصين مشاريعها، إن هو إلا عبارة مفرغة من أي عمق فكري، أو حتى فهمٍ للمجتمعات التي تمر بها، هذا الفصل الاقتصادي في العقل الصيني لن يحمل سوى المزيد من الفشل، ومشاريعها في باكستان خير مثال على هذا التعثر المستمر.
منذ عدة أيام لقي 11 شخصا مصرعهم في كراتشي ، في تدافع حصل خلال توزيع أغذية بمناسبة شهر رمضان، فالدولة البالغ عدد سكانها 230 مليوناً غير قادرة على الوفاء بديونها الخارجية، والانهيار الاقتصادي وشيك فيها، على حين أن الصين الحليف الذي بدأ فيها مشاريع كبرى للبنية التحتية، تقف حائرة أمام دعم الدولة المنهارة مالياً وسياسياً للاستمرار في مشروع طريق الحرير، على حين أن باكستان قاب قوسين أو أدنى من حرب داخلية، سواء بالحرب التي أعلنتها الدولة ضد الجماعات المتطرفة في البلاد، أو الحرب المحتملة بين أنصار شريف وخان المتصارعين على السلطة.
هذا المثال البسيط، يثير في الذهن أسئلة حول أقطاب محتملة غير حاملة لفكرٍ يمهد حضورها في المجتمعات المحلية الجاهزة للصراع، وفكر السوق وحده يحتاج إلى أرض سليمة من هذه الصراعات البينية. تتبلور الأقطاب المتعددة، لكن الهيولى المتبدلة لن تكون بقوة القطب القديم، المتطور تكنولوجياً وفكرياً مثل الولايات المتحدة.
سوف تحمل القوى الجديدة مسؤولية أمنها وأمن الطرق التجارية التي تنشد السير فيها، وهذا بحدّ ذاته يقلل الأعباء العالمية التي تتحملها الولايات المتحدة، سينمو الاقتصاد في الهند وينمو معه بناء القوة العسكرية، وستستمر اليابان المسالمة في مضاعفة الإنفاق الدفاعي، أما دول الخليج فسوف تبحث عن التقية إقليمياً كما فعلت باتفاقها مع إيران. لتبقى المرونة في هذه التحالفات حاملاً آخر هشاً، يخلق حالة عدم اليقين في النظام العالمي.