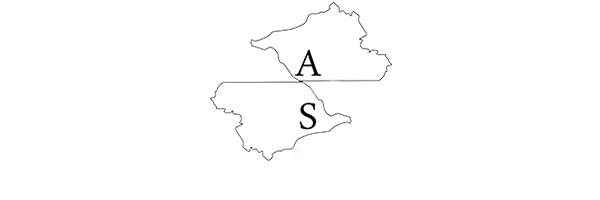التحوّل السعودي منطق وبنية الحرب الباردة الشرق أوسطية الجديدة
حسين أبو بكر منصور
الدراسة منشورة في critiqueanddigest.substack.com
العنوان باللغة الإنجليزية: The Saudi Pivot
The Logic and Structure of the New Middle Eastern Cold War
في منتصف ستينيات القرن العشرين، نشر مالكوم كير كتابه «الحرب العربية الباردة»، وهو عمل فرض في حينه انضباطًا تحليليًا غير بديهي على منطقة اعتادت أن تُقرأ من خلال عدسة ضيقة تختزلها في صراع واحد شامل. وعلى خلاف النزعة السائدة التي تعاملت مع الصراع العربي–الإسرائيلي بوصفه المحرّك الأساسي لسياسات الشرق الأوسط، أعاد كير بناء صورة المنطقة كنظام تتنافس فيه الدول العربية — علنًا وبلا هوادة — على الصدارة، والشرعية، وسلطة تحديد الأجندة السياسية الإقليمية. وغالبًا ما كان الصراع مع إسرائيل يُدار عبر هذا التنافس العربي الداخلي، أو يُخضع له، بل وكان أحيانًا نتيجةً له؛ إذ أدّى وظيفة رأس مال رمزي وأداة نفوذ استراتيجي في صراعات الناصريين، والبعثيين، والملكيات، والجمهوريات الثورية.
غير أن هذه الطريقة الواقعية في النظر إلى المنطقة تلاشت إلى حدٍّ كبير مع تراكم ضغوط لاحقة. فقد أعادت الثورة الإيرانية عام 1979، وصعود الحركات الإسلامية العابرة للحدود وتحوّلها إلى ظواهر مؤسسية، إضافة إلى ترسّخ الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني بوصفه قضية عالمية دائمة، تنظيمَ عملية صنع السياسات، والنشاط السياسي، والبحث الأكاديمي. ومع مرور الوقت، هيمن إطاران تفسيران على حساب معظم غيرهما وأصبحا يسيطران على تحليل المنطقة. أولهما الصراع الاستراتيجي والطائفي بين إيران والدول العربية، الذي أعاد صياغة السياسة الإقليمية بوصفها مواجهة بين بنيات أمنية متنافسة ومطالب متعارضة بالقيادة الأيديولوجية. وثانيهما الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، الذي تصلّب ليغدو محورًا أخلاقيًا ودبلوماسيًا مستدامًا دارت حوله مرارًا وتكرارًا آراء الرأي العام الدولي، والتعبئة الداخلية، وسياسات التحالفات. وأمام هذين المجالين الجاذبين، تراجع التنافس العربي–العربي إلى خلفية المشهد.
لقد حان الوقت لتحديث منظورنا والاعتراف بالدينامية المتجددة للتنافس على الهرمية، بوصفها القوة الدافعة للسياسات الإقليمية اليوم.
فعلى مدى أكثر من عقد، شكّلت السعودية والإمارات العربية المتحدة المحور المركزي لما كان يُعرف بالسياسات العربية «المعتدلة». فقد نسّقتا مواقفهما في اليمن، وواجهتا قطر بشكل مشترك، ورعتا ردود الفعل المضادة للثورات بعد الربيع العربي عام 2011، وقدّمتا نفسيهما لواشنطن باعتبارهما الشريكين العربيين الأكثر موثوقية في المنطقة. غير أن السعودية باتت اليوم تغيّر هذا المسار، وتعيد تموضعها سعيًا إلى الصدارة الإقليمية في شرق أوسط تعتقد أنه سيأخذ قريبًا شكلًا مختلفًا تمامًا.
فبعد عقد من المغامرات المكلفة وغير الحاسمة — من الفشل في فرض تسوية في اليمن، إلى العجز عن إخضاع قطر عبر العزل القسري، إلى العوائد الإقليمية المحدودة لرؤية 2030، وصولًا إلى تصاعد التنافس الاقتصادي والاستراتيجي مع أبوظبي — يبدو أن صانعي القرار في السعودية توصلوا إلى استنتاج مختلف بشأن المسار الأمثل لتراكم القوة الإقليمية في الظروف الراهنة. إن توطيد العلاقة مع تركيا، وتجديد الاستثمار في شرعيات إسلامية ومعادية للصهيونية، والتجميد المتعمّد لمسار التطبيع مع إسرائيل، والمواجهة العلنية مع الإمارات عبر ساحات متعددة، كلها مؤشرات واضحة على هذا التحوّل الاستراتيجي الكبير. ويقف خلف ذلك رهان استراتيجي مفاده أن الشروط التي قادتها الولايات المتحدة وجعلت الاصطفاف الخليجي خيارًا عقلانيًا آخذة في التآكل، وأن السعودية تعتزم قيادة المنطقة في أي عالم ما بعد ليبرالي قد يتشكّل لاحقًا. لم تعد الرياض فاعلًا محافظًا يسعى إلى الحفاظ على تراتبية موروثة، بل باتت تتصرف بوصفها مديرًا مراجِعًا للنظام — مستعدة لتحدي الشركاء القدامى، وإعادة ترتيب الاصطفافات، وإعادة تعريف المبادئ التي تقوم عليها السياسة الإقليمية.
وكانت الشرارة المباشرة لهذه التحولات هي التطورات التي شهدها اليمن، والتي بدأت الشهر الماضي. فقد تقدّمت قوات مدعومة من الإمارات إلى داخل أراضٍ خاضعة للسيطرة السعودية في الجنوب، واستولت على بنى تحتية للطاقة بأقل قدر من المقاومة. وردّت الرياض بهجوم مضاد مستمر دفع الوكلاء الإماراتيين إلى التراجع، وأرسل إشارة واضحة إلى استعدادها لمنازعة المواقع الإماراتية عبر مسرح العمليات بأكمله. وسرعان ما رافق الاشتباك العسكري حربٌ إعلامية. إذ اتهمت وسائل إعلام موالية للسعودية الإماراتَ بالترويج للنزعات الانفصالية، وتقويض وحدة الأراضي العربية، والعمل كقناة لمخططات إسرائيلية خبيثة. في المقابل، صوّرت المنصات الإعلامية الإماراتية السعوديةَ على أنها متهوّرة، ومؤدلجة إسلاميًا، وغير مؤهلة لإدارة الاستقرار الإقليمي.
إن هذه المواجهة مع الإمارات، وما يترتب عليها من انتهاء العلاقة السعودية–الإماراتية بوصفها محورًا مستقرًا، تمثل أولى التعبيرات الظاهرة عن انتقال أوسع في النظام الإقليمي: انتقال من منطقة كانت منظَّمة حول اصطفاف مُدار، إلى أخرى تقوم على منافسة مفتوحة بين قوى متوسطة تسعى إلى المكانة، ضمن شروط تعددية قطبية تنافسية لا يكون فيها الصراع طارئًا أو عرضيًا، بل بنيويًا.
ـ شروط ما بعد الليبرالية
إن عودة مركزية التنافس العربي–العربي تعكس تحوّلًا بنيويًا في السياسة الدولية يتجاوز الشرق الأوسط بكثير، وهو تحوّل يُشار إليه بما بعد الليبرالية. فهذه البيئة التنافسية الجديدة تمثل تعبيرًا مبكرًا عن ديناميات يُرجّح أن تتعمم عالميًا مع نضوج البيئة ما بعد الليبرالية: تراجع التحكيم الهيمني، تصاعد تنافس القوى المتوسطة، تقلّص النفاذ إلى المؤسسات، تزايد أهمية الرافعة الموقعية، ضعف القواعد، وضرورة انتزاع المكانة بدل افتراضها. وفي ظل شروط ما بعد الليبرالية، تُولَّد العوائد من خلال الموقع لا من خلال المشاركة. إذ بات التحكم في ممرات اللوجستيات، وتدفقات الطاقة، وقنوات الاستثمار، ومنصات السردية، ومحافظ الصراعات، أكثر أهمية بكثير من المكانة الشكلية داخل المنتديات الدولية.
إن النظام الدولي الليبرالي الذي تكرّس بعد الحرب الباردة يشهد انكماشًا واضحًا، كما يتجلى في التطورات الأخيرة للسياسة الخارجية الأمريكية: الحروب التجارية، الأحادية في اتخاذ القرار، إنهاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونظامها القائم على المنظمات غير الحكومية، الانسحاب من المؤسسات الدولية، والتخلي العلني عن الأطر القائمة على القواعد من قبل أبرز مهندسيها. لم تعد واشنطن تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر التبرير الليبرالي، بل باتت تعتمد على إسقاط القوة والإكراه الصريح. ولم يعد النظام الدولي ما بعد الليبرالي احتمالًا مستقبليًا، بل أصبح بيئة التشغيل الفعلية.
وما يتبلور ليس تعددية قطبية بالمعنى الكلاسيكي — أي توزيعًا مستقرًا للقوة بين كتل من القوى العظمى — بل واقعًا أكثر سيولة وأقل قابلية للتنبؤ: بيئة ما بعد ليبرالية انتهت فيها الهيمنة الأمريكية القائمة على القواعد، أو بتعبير أدق، لم تعد الهيمنة الأمريكية محكومة بالقواعد. ولم يعد النفاذ إلى الأسواق ورأس المال وضمانات الأمن يُكتسب عبر الامتثال المؤسسي، بل أصبح أمرًا يُساوَم عليه مرارًا، ومن موقع قوة تفاوضية.
أما الاستجابة الاستراتيجية عبر مختلف المناطق فقد تمثلت في السعي إلى الاستقلالية: تقليص الاعتماد على راعٍ واحد، وتنويع الشراكات، وتراكم أوراق الضغط. فالهند تناور بين واشنطن وموسكو، وتركيا توازن بين الناتو وروسيا والخليج، فيما ترفض البرازيل وجنوب أفريقيا الاصطفاف في ملف أوكرانيا. وليس هذا عدم انحياز بالمعنى الذي ساد منتصف القرن العشرين، بل مناورة موقعية داخل نظام أقل انضباطًا وأكثر تعاملية. ولم يعد رأس المال الدبلوماسي يُراكَم عبر سمعة ضبط النفس، بل من خلال القدرة المُثبتة على التعطيل أو التأخير أو إعادة توجيه النتائج عبر ساحات متعددة.
لم يخضع الشرق الأوسط يومًا بالكامل لمعايير النظام الليبرالي. فاختراق السيادة، واستمرار السلطوية، وتدخل القوى الكبرى دون مساءلة — كلها سمات طبعت عمل المنطقة في ظل استثناء جزئي سبق التفكك الراهن بوقت طويل. غير أن هذا الاستثناء نفسه كان منظمًا ضمن الهيمنة الأمريكية. فقد رسمت واشنطن الخطوط الحمراء، وقمعت التنافسات داخل معسكر الحلفاء، وقدمت ضمانات أمنية، وأتاحت مسارًا لاكتساب المكانة عبر الاصطفاف. وتعلّمت الملكيات الخليجية كيف تناور داخل هذه البنية؛ صحيح أنها لم تستبطن معاييرها، لكنها كانت دائمًا تحترم قيودها وتعتمد عليها.
غير أن تلك القيود آخذة في التلاشي، وأصبح التحكيم الأمريكي تعامليًا وغير موثوق. ولا يزال الغطاء الأمني قائمًا، لكن نطاقه بات غير مؤكد. ولم تعد المكانة تُكتسب حصريًا عبر القرب من واشنطن. لقد ضعفت القيود من دون أن تختفي، وتشوّشت الهرمية من دون أن تنهار. وفي مثل هذه البيئة، تكافئ الظروف الدول التي تمتلك الموارد والطموح على السلوك الحازم، وربط القضايا ببعضها، وتراكم قدرة الفيتو.
أما الدول التي استوعبت هذه التحولات في وقت مبكر — السعودية، والإمارات، وتركيا، وإسرائيل — فقد بدأت بالفعل إعادة تموضعها على هذا الأساس، من دون انتظار تبلور نظام جديد. وهي تتنافس على تشكيله، في منافسة يُرجّح أن تتحول هي ذاتها إلى النظام الجديد: نظام أرقّ، وأكثر تساهلًا، وبنيويًا أكثر تنافسية.
ويجب قراءة التحوّل السعودي في هذا السياق، وكذلك في ضوء عامل ثانٍ لا يقل حسمًا: إعادة ترتيب دونالد ترامب الأحادية لأسواق الطاقة العالمية. فالاستراتيجية الإقليمية السعودية تقوم على ريع النفط؛ ومن دون ارتفاع عائداته تصبح النفقات الداخلية والإقليمية غير قابلة للاستدامة. غير أن السياسة الأمريكية تهدد هذا الأساس عبر فائض عرض بنيوي في سوق يعاني أصلًا من تقلبات سعرية، ما يقوض نفوذ «أوبك+» في اللحظة التي تحتاج فيها الرياض إليه بأشدّ ما يكون. إن التوجّه نحو التحكم في الأجندة، والوصاية الرمزية، والتعبئة الانتقائية، لا يمثل ارتدادًا أيديولوجيًا إلى «حمض نووي» إسلامي وهابي بدائي يُعاد تفعيله، بل هو تكيّف مع واقع جديد — واقع أصبحت فيه الأفعال الأمريكية غير قابلة للتنبؤ، لا في المجال الأمني فحسب، بل في القاعدة الاقتصادية ذاتها التي تجعل القوة السعودية ممكنة.
الفراغ المزدوج
إذا كانت ما بعد الليبرالية هي الشرط الكلي الحاكم، فإنها على المستوى الإقليمي أفضت إلى تشكيلة محددة من العوامل غيّرت بنية الفرص في المنطقة. وقد تمثّل ذلك في تطورين متزامنين ومحدّدين: تحوّل الولايات المتحدة من مدير للنظام إلى مشارك انتقائي، وتفكيك النظام المقابل الوحيد المتماسك، أي محور «الشيعة»، الذي كان قد قيّد التنافس داخل الإقليم لأكثر من عقدين.
ولا تزال الولايات المتحدة الفاعل العسكري الخارجي المهيمن في الشرق الأوسط، غير أن دورها تبدّل من حيث الوظيفة والنطاق. فلم تعد واشنطن تضمن مخرجات سياسية، ولا تفرض انضباط التحالفات، ولا تستثمر رأس مال سياسيًا طويل الأمد في صياغة تسويات إقليمية. وأصبحت تدخلاتها متقطعة، ومحددة بالمصلحة، ومنفصلة على نحو متزايد عن أي أهداف أوسع لبناء نظام إقليمي. كما تحولت الضمانات الأمنية إلى ضمانات مشروطة وتعامليّة، مع تركيز على التوازن العام.
ويعني هذا التحول أن الفاعلين الإقليميين لم يعودوا يعملون ضمن تراتبية واضحة التطبيق، ولا ضمن إطار مستقر للتوقعات بشأن الخطوط الحمراء الأمريكية، أو التزامات التحالف، أو إدارة التصعيد. والنتيجة هي قدر أكبر من السماحية: نظام تُفوض فيه المبادرة، ويُحمَّل فيه الفاعلون الإقليميون أنفسهم كلفة المخاطر. وفي الوقت ذاته، جرى تفكيك آخر نظام مقابل مستدام في المنطقة.
فعلى مدى معظم الفترة التي تلت عام 2003، عمل ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بوصفه بنية رخوة لكنها متماسكة عملياتيًا، تربط بين إيران وحزب الله وسوريا وفصائل فلسطينية وميليشيات حليفة عبر العراق واليمن. وقد فرض هذا المحور شكلًا من «النظام السلبي»؛ إذ قيّد حرية الحركة الإسرائيلية، وحدّ من الاستقلالية الاستراتيجية العربية، وفرض سقفًا فعليًا لإعادة الاصطفاف الإقليمي عبر التهديد بتصعيد متعدد الجبهات.
غير أن هذه البنية تعرّضت لتآكل منهجي خلال العامين الماضيين بفعل يحيى السنوار. فقد أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى قطع شبكات القيادة، وتدمير ممرات الإمداد اللوجستي، وتصفية القيادات العليا، وشلّ البرنامج النووي الإيراني، وإحداث تغيير في النظام بسوريا، وإجبار التشكيلات الوكيلة الأساسية على التشتت أو نزع التعبئة. وما تبقى اليوم هو مجموعة من فاعلين محليين منهكين يعملون تحت قيود مالية خانقة، وتشبع استخباراتي كثيف، وسقوف تصعيد آخذة في الانخفاض، تفرضها كل من قوة الردع الإسرائيلية واقتراب الدولة الإيرانية نفسها من حالة الانهيار.
والأثر التراكمي لذلك هو انهيار الثنائية القطبية المتبقية. فقد فقد النظام الذي كان منظمًا حول قوتين حدّيتين — الإدارة الأمريكية من جهة، والمقاومة بقيادة إيران من جهة أخرى — كلا الركيزتين. ومع تراجع القيود الخارجية وتلاشي السقوف النظامية، تصبح المنافسة مباشرة، وموقعية، وعسيرة الاحتواء. وتغدو الدول أقل اعتمادًا على المكانة المؤسسية في تراكم النفوذ، وأكثر تركيزًا على السيطرة على الممرات، ومسارات الاستثمار، ومنصات السردية، ومحافظ الصراعات. وهي تسعى إلى نقاط فيتو، وتبني أوراق ضغط عبر ساحات متعددة، وتتعامل مع القضايا الرمزية بوصفها أدوات من أدوات فن الحكم.
ـ القوى الجديدة والقديمة
في مثل هذا النظام الإقليمي المتّسم بالسماحية، يُراكَم النفوذ عبر حزم من القدرات يمكن تفعيلها عبر المجالات الاقتصادية والسياسية والمعلوماتية والأمنية. ولم تعد السعودية، والإمارات، وقطر، وتركيا، وإسرائيل تتنافس بوصفها حلفاء أو خصومًا تقليديين بقدر ما تتنافس بوصفها تشكيلات قوة متمايزة، صُمِّم كلٌّ منها ليُحسّن نمطًا خاصًا من أدوات النفوذ.
ترتكز حزمة السعودية على الثروة، والحجم، والسلطة الرمزية. فهي الدولة العربية الوحيدة التي تجمع بين الثقل الديمغرافي، والقدرة المالية، ووصاية أقدس المواقع في الإسلام. وتُنتج هذه السمات شكلًا من الشرعية الجماهيرية لا يتوافر لنظرائها الخليجيين، ولا للدول غير العربية، فضلًا عن دولة يهودية صغيرة، كما يستحيل استنساخه عبر الاستثمار المادي. وتملك الرياض قدرة على تعبئة الرأي العام الإقليمي، وصياغة الخطاب، وإعادة تعريف الأولويات السياسية بطرق تعجز عنها الدول الأصغر. كما أن سيطرتها على البنية التحتية الدينية تُرسّخ السلطة السعودية في صميم الاقتصاد السياسي اليومي للعالم الإسلامي.
وتتحول هذه الأصول البنيوية بسهولة إلى رأس مال رمزي. وقد أدركت السعودية أنها تحتل موقعًا فريدًا يؤهلها للمطالبة بالوصاية على «الملفات الأخلاقية» الإقليمية — وفي مقدمتها فلسطين — وتحويل هذه الوصاية إلى قوة في تحديد الأجندة، بما يجعل الموقف المناهض للصهيونية أكثر جدوى من مسار التطبيع. ومن ثمّ، فإن التعبئة السردية ليست عنصرًا ثانويًا في الاستراتيجية السعودية، بل مكوّنًا جوهريًا فيها. ففي نظام تتنازع فيه الشرعية على نحو متزايد، تصبح القدرة على تعريف ما يُعدّ استقرارًا أو تفككًا أو تطبيعًا أو خيانة شكلًا من أشكال القوة الصلبة بوسائل أخرى. وتعكس الأنشطة الدعائية السعودية المكثفة الراهنة محاولة لتحويل هذا التفوق الرمزي إلى أداة دائمة لإدارة النظام الإقليمي.
أما الحزمة الإماراتية فمُنظَّمة وفق منطق مختلف. إذ تعوّض الإمارات محدوديتها الديمغرافية والرمزية بتركيز عالٍ من القوة المادية والشبكية. فهي تسيطر على شبكة كثيفة من الاستثمارات، والبنى التحتية اللوجستية، والموانئ التجارية، والمناطق الحرة، ورأس المال السيادي، والشراكات الأمنية، تمتد من شرق المتوسط إلى القرن الأفريقي والمحيط الهندي. وتتيح هذه الأصول لأبوظبي الاندماج العميق في سلاسل الإمداد، والدورات المالية، ونقاط الاختناق البحرية، بما يمنحها نفوذًا بنيويًا من دون الحاجة إلى تعبئة سياسية.
ويُفضّل هذا النموذج بطبيعته الترابط النخبوي على أي شكل من أشكال السياسة الجماهيرية. إذ يُمارَس النفوذ عبر العقود، وحقوق التموضع العسكري، والتعاون الاستخباراتي، والاعتماد الاستثماري، لا عبر الجاذبية الأيديولوجية. غير أن التصميم ذاته الذي ينتج الكفاءة يفرض أيضًا حدودًا. فالإمارات تمتلك قدرة محدودة على اختراق السرديات خارج دوائر النخب المعولمة، كما تفتقر إلى المرونة في المجال المعلوماتي حين تُعاد صياغة النزاعات بلغة شعبوية أو دينية. ولهذا الاختلال دلالة استراتيجية بالغة.
وتحتل قطر موقعًا ثالثًا. فمع افتقارها إلى حجم السعودية أو عمق البنية التحتية الإماراتية، تخصّصت في إنتاج السرديات، ورعاية الإسلاميين، والوساطة. ولا تزال قناة الجزيرة المنصة الإعلامية العربية العابرة للحدود الأكثر فاعلية، والقادرة على تشكيل الأجندات العامة وإعادة تأطير الصراعات عبر المنطقة. كما يوفّر الاستثمار القطري طويل الأمد في الشبكات الإسلامية منفذًا إلى فاعلين من غير الدول يعملون حيث تعجز الدبلوماسية الرسمية عن الوصول.
وتبلغ الميزة النسبية لقطر ذروتها في الأنظمة غير المحسومة. فهي تولّد النفوذ عبر استضافة المفاوضات، وتمويل القنوات، وتقديم نفسها بوصفها طرفًا لا غنى عنه للتواصل مع فاعلين يرفض الآخرون — أو يعجزون عن — التعامل معهم. وتسوق الدوحة هذا الدور بوصفه «وساطة» لا قوة، مقدِّمة نفسها كبنية تحتية لا كمنافس. غير أن الأثر العملي لذلك هو تحويل الصراع إلى أصل استراتيجي: فكلما بقي الملف مفتوحًا، ازدادت قيمة النفاذ القطري، والموارد المالية، والقدرة السردية. فالاستقرار يقلّل من قيمة الوساطة، بينما يرفعها الجمود. ولهذا، يرتبط النفوذ القطري بنيويًا باستمرار الملفات السياسية المفتوحة.
وقد استثمرت الدوحة أيضًا بكثافة في منظومات النخب الغربية — من جامعات، ومراكز تفكير، وشركات استشارية، ولوبيات، ووسائل إعلام رفيعة المستوى، ومؤسسات ثقافية، وشبكات المكانة والهيبة — ما أوجد قناة موازية للنفوذ تعمل عبر المكانة، والتوظيف، والرعاية، لا عبر الضغط الرسمي وحده. ويمنح هذا قطر قدرة على تشكيل الأطر التفسيرية داخل دوائر صنع السياسات الغربية والتكنوقراطية، وعلى تحصين موقعها الإقليمي بطبقة كثيفة من العلاقات السمعة والمؤسسية.
أما الحزمة التركية فتقوم على المركزية الجغرافية والقدرة الإكراهية. فهي تجمع بين جيش تقليدي كبير، وقاعدة صناعات دفاعية آخذة في التوسع، وسيطرة على ممرات عبور حيوية تربط أوروبا بالبحر الأسود والشرق الأوسط. وقد رسّخ استخدام أنقرة للطائرات المسيّرة، والانتشار العسكري الخارجي، والقوات الوكيلة المُدارة، مكانتها بوصفها أكثر القوى المتوسطة مرونة عملياتيًا في المنطقة.
سياسيًا، تقرن تركيا هذه القدرات باصطفاف أيديولوجي انتقائي، فتتموضع راعيةً للحركات الإسلامية السنية حين يكون ذلك مجديًا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على علاقات تعاملية مع روسيا، وحلف الناتو، وإسرائيل، ودول الخليج. ويتيح ذلك لأنقرة التنقل بين عضوية التحالفات، والتدخل المستقل، والتعطيل. ويستمد نفوذها قوته أقل من السلطة الرمزية، وأكثر من قدرتها على إدخال نفسها إلى ساحات متنازع عليها وتغيير موازين القوى المحلية بتكلفة منخفضة نسبيًا.
أما الحزمة الإسرائيلية فهي أضيق نطاقًا لكنها شديدة الكثافة. إذ ترتكز على التفوق التكنولوجي، والهيمنة الاستخباراتية، والسيطرة العسكرية، والمكانة المميزة في واشنطن، والتحكم في التصعيد الإقليمي. وتُمكّن هذه الأصول إسرائيل من إضعاف خصومها بسرعة، وفرض خطوطها الحمراء، وتشكيل البيئات الأمنية المجاورة من دون احتلال إقليمي أو هياكل تحالف رسمية. وتُفضّل عقيدتها الاستراتيجية المنع على الترسخ: منع تشكّل دول معادية، وتعطيل اندماج الخصوم، والحفاظ على حرية الحركة عبر مسارح متعددة.
وقد وسّع التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب نطاق الوصول الاقتصادي واللوجستي لإسرائيل، غير أن رافعتها الأساسية لا تزال إكراهية. فإسرائيل لا تنافس — ولا تستطيع — على الشرعية الإقليمية؛ بل تنافس على التفوق العملياتي والعمق الاستراتيجي. وفي بيئة ما بعد ليبرالية، يجعلها ذلك فاعلًا قويًا لكنه مُربك بنيويًا، قادرًا على تفكيك الأنظمة المقابلة، لكنه ضعيف التموضع لقيادة أي نظام بديل. وبالنظر إلى هذه الحزم مجتمعة، يتضح لماذا يُستبعد أن تنتهي المنافسة الراهنة إلى كتل مستقرة. فكل فاعل يراكم القوة عبر قنوات مختلفة، وبآفاق زمنية متفاوتة، ونقاط ضعف متباينة.
ـ الترسّخ مقابل المنع
باتت عدة من أكثر النزاعات تأثيرًا في المنطقة اليوم تدور حول سؤال واحد: أيّ الوحدات السياسية في الشرق الأوسط يُسمح لها بالترسّخ والتماسك، وأيّها يجب أن يُبقى مجزّأً ومقيَّدًا على نحو دائم. وعلى خلاف ما تدّعيه الدعاية السعودية والقطرية، فإن الإجابة الحقيقية ليست عقائدية، بل ظرفية بحتة. فكل فاعل رئيسي يؤيد السيادة حين يؤدّي الترسّخ إلى إنتاج قوة صديقة، ويقاومها حين يفضي الترسّخ إلى نشوء منافس قادر على تثبيت اصطفاف معادٍ. والتجزئة ليست فئة أخلاقية؛ إنها مآل توازني في ساحات لا تستطيع فيها أيّ كتلة فرض تسوية مفضلة، وحيث تصبح القابلية للاختراق نفسها مصدرًا للنفوذ.
يقوم هذا المنطق في صلب التنافس السعودي–الإماراتي، ويتفاعل مع حزم النفوذ التي جرى توصيفها أعلاه. إذ تحاول السعودية إعادة فرض أسبقيتها في تحديد الأجندة من خلال تشكيل النهايات السياسية المسموح بها عبر مجموعة من المسارح المترابطة. في المقابل، تسعى الإمارات إلى تحقيق الأفضلية عبر النفاذ المعياري، ولا سيما في السياقات التي تكون فيها السلطة المركزية ضعيفة. أما قطر فتستفيد من دور الوسيط ومن التحكم في السرديات داخل الملفات غير المحسومة، لكنها تحتاج أيضًا إلى محاورين يتمتعون بحد أدنى من التماسك المؤسسي بما يسمح بتحويل الوساطة إلى قيمة سياسية. وترتكز تفضيلات تركيا على المصالح الاقتصادية، وأمن الحدود، والمسألة الكردية. في حين تمنح العقيدة الإسرائيلية الأولوية لحرية الحركة ومنع التهديدات، ولذلك تميل إلى معارضة نشوء جيران كبار ذوي تعبئة أيديولوجية وعمق استراتيجي، حتى حين تتسامح تكتيكيًا مع أشكال محدودة من النظام المحلي.
وليس اليمن سوى الحالة الأوضح. فالمصلحة الجوهرية للرياض هي التحكم في مآل الصراع: منع اليمن من التصلّب في جغرافيا سياسية لا تستطيع السعودية تشكيلها، وتستدعي بصورة دائمة اختراقًا منافسًا على طول مدخل البحر الأحمر. إن يمنًا مجزّأً إلى مجالات نفوذ مستقرة — ولا سيما كيانًا جنوبيًا يعتمد على شبكات الأمن والتجارة الإماراتية — يقلّص النفوذ السعودي على أي تسوية محتملة، ويحدّ من قدرتها على التفاوض مع مركز سيادي واحد، ويؤسّس لمصلحة منافسة على التخوم المباشرة للمملكة. ومن غير المرجح أن يشكّل جنوب مدعوم إماراتيًا تهديدًا عسكريًا مباشرًا للأراضي السعودية؛ لكن المشكلة أنه قد يرسّخ خريطة لم تعد فيها السعودية الفاعل الأساسي في اليمن، وتُدار فيها ممرات البحر الأحمر المحاذية لمصالحها عبر ترتيبات خارجة عن سيطرة الرياض.
أما مصالح أبوظبي فتتمحور بدرجة كبيرة حول الممرات. فقد استثمرت الإمارات في العقد البحرية، والقوى المحلية، والترتيبات الجنوبية التي تضمن النفاذ والتأثير حتى في غياب دولة يمنية موحّدة. ويتقاطع هذا النهج بطبيعته مع مجموعة التفضيلات الإسرائيلية في البحر الأحمر: تقييد قدرات الحوثيين، وحماية الملاحة، وبناء تعاون أمني بحري متدرج يحافظ على حرية الحركة العملياتية. ويمكن لهذه الأهداف أن تتلاقى على الساحل، لكنها تتباعد عند مستوى النهايات السياسية. فما يبدو لأبوظبي والقدس إدارةً كفؤة للممرات، قد يبدو للرياض تطويقًا مستدامًا للنفوذ، وترسيخًا لبنية وصول منافسة على الجناح الجنوبي للمملكة. ولهذا يتحول اليمن إلى صراع على المآلات، لأن الرياض تخشى امتلاك دولة أخرى قدرة فيتو على المجالين السياسي والبحري الأقرب إلى أسبقيتها الإقليمية.
وتتكرر هذه المنطقية في سوريا، ولكن على رهانات أعلى. إذ تتقاطع السعودية وتركيا وقطر عند تفضيل قيام دولة سورية متماسكة تقودها أغلبية سنية، لأن ذلك سيضيف حليفًا كبيرًا. كما أن البديل هو فضاء قابل للاختراق الدائم: ممرّ للتدخل الخارجي، والقوى المتمرّدة، والمشاريع الانفصالية المستمرة. وأيًا يكن ما قد يلحق بالأقليات — المسيحيين، والعلويين، والدروز، والأكراد — ومهما بلغ العنف، فإنه يُعدّ كلفة مقبولة في سبيل هذا الترسّخ السني للسلطة. ويُعدّ الموقف التركي الأشدّ حدّة: فالحكم الذاتي الكردي مرفوض رفضًا قاطعًا، لما له من تداعيات مباشرة على الأمن الداخلي التركي.
وتختلف التفضيلات الإسرائيلية، لأن إدراك إسرائيل للتهديد يتمحور حول منع نشوء جار متماسك، معادٍ أيديولوجيًا، أي سوريا إسلامية جديدة تتحول إلى «تركيا 2.0». فسوريا سنية إسلامية سلطوية، متحالفة مع أنقرة ومعاد إدماجها في الدبلوماسية العربية، لا تُعدّ «استقرارًا» من منظور القدس، بل عودة خصم يمتلك قدرة تعبئة سنية إسلامية وعمقًا استراتيجيًا — وهو سيناريو غير مقبول على الإطلاق، لا سيما في أعقاب مجازر السابع من أكتوبر. ولذلك تميل السياسة الإسرائيلية إلى المنع والتخريب الاستراتيجي: إضعاف القدرات، وفرض سقوف، وبناء نفوذ فعلي مع الأقليات الطرفية، وضمان أن أي ترسّخ سوري — إن حدث أصلًا — يبقى مقيَّدًا وقابلًا للعكس عند الضرورة.
وفي السودان، تُعدّ الحرب أيضًا صراعًا على أيّ تحالف خارجي سيرث النفوذ على الجهاز القسري للدولة واصطفافاتها الخارجية. فالسودان الموحّد تحت قيادة واحدة يمكنه تأمين طرق خلفية رئيسية تربط مصر بالبحر الأحمر والساحل الأفريقي، كما يمكنه تثبيت اصطفاف يخدم رعاة خارجيين أو يهددهم. ولهذا تحوط الجهات الخارجية. أما ليبيا، فهي الصراع نفسه ولكن ضمن أفق زمني أطول وتقسيم خارجي أوضح. إذ تهدف السيطرة العسكرية والاستثمار السياسي التركي في غرب ليبيا إلى تأمين مركز حكم في طرابلس يتوافق مع المصالح البحرية والأمنية التركية، في حين يعكس الدعم الإماراتي والمصري لمراكز القوة في الشرق مشروع ترسّخ بديلًا قائمًا على أولوية الأمن ومناهضة الإسلاميين. وحين يعجز أي طرف عن فرض احتكار وطني للقوة، تبقى ليبيا بنية معيارية: سلطات متعددة، وسيادة قابلة للتفاوض، ومساومات متكررة حول البنية التحتية للطاقة، والموانئ، والمؤسسات الأمنية.
ويمتد هذا الصراع على النهايات السياسية إلى القرن الأفريقي وممر البحر الأحمر خارج القلب العربي. وتُعدّ صوماليلاند حالة شديدة الوضوح، لأن الاعتراف الإسرائيلي–الإماراتي بها ليس مجرد فعل قانوني، بل اختيار لنهاية سياسية. فمن منظور السعودية، يُعدّ الاعتراف الرسمي بصوماليلاند عامل زعزعة، لأنه يشرعن الانفصال كأداة، ويُدخل منصة دائمة للنفوذ الخارجي على باب المندب. وتعكس معارضة الرياض لذلك خشيتها من السابقة ومن انكشاف الممرات. أما الإمارات، فإن استثمارها العميق في موانئ صوماليلاند وبناها الأمنية ينسجم مع منطق النفاذ المعياري: كيانات ساحلية ذاتية الحكم يمكنها توفير تموضع موثوق ونفوذًا بأقل قدر من القيود.
أما إيران، فهي الساحة التي تتباين فيها تفضيلات النهايات السياسية بأشدّ وضوح. فقد أُضعفت الجمهورية الإسلامية على نحو بالغ: تدهورت شبكتها الإقليمية، واختلّت بنية ردعها، وتعرّض استقرارها الداخلي لضغط متواصل قد يطيح بالنظام، في اللحظة التي تُكتب فيها هذه السطور. ويتمثل الأفق الاستراتيجي الإسرائيلي تجاه إيران في تغيير النظام. فإسرائيل لا تسعى فقط إلى تقليص قدرة إيران على الإسقاط الإقليمي أو إضعاف قدراتها، بل تهدف إلى كسر الجمهورية الإسلامية نهائيًا، من دون إمكانية لإعادة إنتاجها. ولهذا يحتل تغيير النظام موقعًا مركزيًا في مفهوم النصر الإسرائيلي، سواء صيغ كهدف صريح أم بوصفه النتيجة النهائية المقبولة لضغط عسكري متواصل. وقد عكست الرسائل الإسرائيلية الموجهة إلى حركة الاحتجاج الإيرانية هذا التوجّه على الدوام.
أما التفضيلات العربية فهي مختلفة. فالسعودية ودول الخليج الأخرى لا تريد تغيير النظام في إيران. إنها تريد إيرانًا مُذلَّلة، ومقيَّدة، وقابلة للردع، ومعزولة دوليًا — لا دولةً منهارة تتسرّب اضطراباتها إلى الخارج وتنتج خلافة سلطة غير قابلة للتنبؤ وتصعيدًا غير محسوب. لكنها في الوقت ذاته لا تريد إيران علمانية، غنية، ومعاد إدماجها دوليًا — إيران طبيعية اقتصاديًا، وقادرة على علاقات مستقرة مع الغرب وإسرائيل — لأن ذلك سيحوّلها إلى منافس جدي على الصدارة الإقليمية، مع قيود بنيوية أقل وجاذبية أعلى لرأس المال. وتفضّل الرياض إيرانًا ضعيفة، ومعزولة، و«إسلامية»، لأن ذلك يبرّر أمننة السعودية الدينية الخاصة، ويضمن بقاء إيران دولة منبوذة لا منافسًا على الاستثمار الغربي. وبعبارة أخرى، يتمثل التفضيل الخليجي في الاحتواء المُدار: إضعاف إسقاط إيران الخارجي وحصرها، مع تجنب المخاطر النظامية لانهيار النظام، والمخاطر الاستراتيجية لتطبيع إيران.
وفوق ذلك، لا يمكن فصل حسابات الرياض عن ديناميات سوق النفط، ولا سيما في أعقاب التطورات في فنزويلا، وكيف أدخلت الأفعال الأمريكية اختلالات خطيرة على هذه الحسابات.
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم. وتحت حكم مادورو والعقوبات، انهار الإنتاج من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا إلى أقل من 800 ألف. إن إزاحة مادورو وتنصيب حكومة خلف موالية للولايات المتحدة يفتحان احتمال إعادة تأهيل الإنتاج الفنزويلي على نطاق واسع — أي ضخ هائل للمعروض، يُباع بخصومات كبيرة لاستعادة الحصص السوقية، في سوق يعاني أصلًا من مخاوف فائض العرض وتقلب الأسعار. وتنطبق المنطقية نفسها على إيران، ولكن على نطاق أكبر بكثير. فإذا سقطت الجمهورية الإسلامية في ظل موجة الاحتجاجات الحالية، وطبع النظام اللاحق علاقاته مع الغرب، فقد يعود الإنتاج الإيراني إلى أربعة ملايين برميل يوميًا أو أكثر من دون قيود العقوبات. ومجتمعَين، سيؤدي تطبيع الإنتاج الفنزويلي والإيراني إلى تقويض نفوذ «أوبك+» بنيويًا، وفرض ضغط هبوطي مستدام على الأسعار، في اللحظة التي تحتاج فيها السعودية إلى عائدات مرتفعة لتمويل مشاريعها الطموحة — التي تعاني أصلًا — وللدفاع عن موقعها الإقليمي في زمن احتدام المنافسة.
إن ما تريده السعودية ببساطة هو إخراج النفط الإيراني من الأسواق الغربية. فإيران المنبوذة الخاضعة للعقوبات هدية لحصة السعودية السوقية وقدرتها على التحكم في الأسعار. وتشكل التطورات الراهنة تهديدًا طويل الأمد لريوع النفط التي تجعل الاستراتيجية الإقليمية السعودية ممكنة من الأساس. ومن ثم، فإن التحوّل السعودي هو أيضًا تحوّط ضد إعادة ترتيب أمريكية لأسواق الطاقة العالمية لا تستطيع الرياض التنبؤ بها أو التحكم فيها.
وعليه، وعبر هذه المسارح المختلفة، تتصادم المصالح السعودية على نحو متزايد مع العقيدة العملياتية الإسرائيلية بوصف ذلك نمطًا بنيويًا متكررًا. ففي سوريا، يتعارض تفضيل الرياض لسوريا سنية متماسكة — ولو على حساب الأقليات — مع النهج الإسرائيلي القائم على تعزيز الأقليات لمنع الترسّخ. وفي إيران، يتمثل هدف إسرائيل النهائي في تغيير النظام، بينما تريد السعودية إيرانًا إسلامية ضعيفة ومنبوذة، وهكذا.
وتكتسب هذه الصدامات أهمية خاصة لأنها تخلق لا تماثلًا في فضاء المنافسة. فإسرائيل تتفوق في المؤشرات العسكرية والاستخباراتية الحاسمة، ولا تمتلك السعودية أو تركيا أو قطر مسارًا عقلانيًا لـ«منافسة» إسرائيل على ميدانها الخاص. ومن ثمّ، تصبح أدوات الرياض القابلة للاستخدام غير مباشرة. كما أن وضع إسرائيل كدولة منبوذة في السياسة العربية يخلق مساحة واسعة يمكن فيها منازعة النتائج المرتبطة بإسرائيل عبر الحرب السمَعية بدلًا من القوة، حيث تُدفع الكلفة السياسية للمواجهة من قبل دول منافسة لا من قبل المتحدّي نفسه. والنتيجة هي الإزاحة: تتحول أبوظبي إلى هدف وكيل عملي. فالتوافق الأمني الإماراتي مع إسرائيل يوفّر للرياض بديلًا خطابيًا فعّالًا، يسمح بإعادة ترميز نزاعات النهايات السياسية الملموسة في إطار سردي واحد قابل للتعبئة. ولا يُلغي ذلك التنافس السعودي–الإماراتي، لكنه يضاعف حدّته بنقله إلى الساحة الوحيدة التي تمتلك فيها السعودية تفوقًا مقارنًا حاسمًا.
ومن هنا، شكّلت فلسطين/مناهضة الصهيونية الساحة التي لجأت إليها الرياض لتركيز هذا التسلسل من صراعات النهايات السياسية في أداة واحدة عالية النفوذ وعالية العائد. فهي أكثر مولدات الشرعية الجماهيرية هشاشةً للنخب في المنطقة، وهي أيضًا الساحة الوحيدة التي يمكن فيها تحويل المزايا المقارنة السعودية الفريدة إلى تحكم واسع في الأجندة. فقوة الإمارات الإقليمية مُحسّنة لدعم نخب موالية للغرب، ومناهضة للإسلاميين، ولنَفاذ قائم على التطبيع؛ لكنها ضعيفة في العمق السياسي الجماهيري، وغير شعبية في سياسات الشارع، ومن ثمّ مكشوفة أمام كلفة الجمهور حين تنتقل المنافسة الإقليمية إلى السجل الرمزي للكرامة العربية والإسلام. ولذلك تصبح فلسطين، بالنسبة إلى الرياض، الأداة الأقل كلفة لإضعاف النفوذ الإقليمي الإماراتي من دون التراجع عن أجندة التحديث الداخلي. إذ تستطيع المملكة الاستمرار في الليبرالية الاجتماعية داخليًا، مع إعادة تفعيل التضامن الإسلامي والمناهض للصهيونية خارجيًا — بصورة انتقائية واستراتيجية، وإلى حدٍّ كبير خارج الحدود — بوصفه أداة من أدوات التنافس الإقليمي ضد الإمارات وإسرائيل. فلننظر في ذلك عن كثب.